الكاتب: Jean-Loup Samaan نقلا عن المجلس الاطلسي/ واشنطن
أيلول-سبتمبر 2025
مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
ترجمة: حسين احمد السرحان
الى جانب قياس مدى التعاون الحالي بين بكين وطهران، فأن التوقيت مهم أيضاً لأنه يأتي في وقت تكثر فيه التكهنات بشأن حرب جديدة بين إسرائيل وإيران. ويُرسل الكشف عن تقييمات الاستخبارات الإسرائيلية رسالةً الى بكين مفادها أنه في ظلّ ما بعد 7 /تشرين الأول، لم تعد إسرائيل تتسامح مع مثل هذه الأنشطة، وقد تتصرّف بناءً عليها. ويهدف هذا الى إقناع الصين بالابتعاد عن عملية إعادة التسلح الإيرانية.
في منتصف آب 2025، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية - نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية مجهولة - بأن الصين "تعمل حالياً على إعادة بناء" ترسانة الصواريخ الإيرانية بعد حرب الأيام الاثني عشر بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. ولم يُقدّم التقرير أي تفاصيل، ولم تؤكده الحكومة الصينية، لكن هذه المزاعم المجهولة تكررت منذ ذلك الحين في الصحف الغربية، مما أثار تكهنات واسعة حول سبب تورط الصين في صراع بدت أنها حريصة على تجنبه.
في الواقع، ليس انخراط الصين في البرنامج الباليستي الإيراني بالأمر الجديد. كونه يعود الى ما بعد الحرب الإيرانية - العراقية عام ١٩٨٨، عندما أعطى النظام في طهران الأولوية لإنتاج الصواريخ. بعد سنوات من المعاناة من هجمات صواريخ سكود العراقية على المدن الإيرانية، أصبحت الصواريخ مكونًا أساسيًا في الاستراتيجية العسكرية لطهران. ولهذا الغرض، اعتمدت طهران على شركاء خارجيين، وتحديدًا كوريا الشمالية والصين، للحصول على التكنولوجيا وتدريب مهندسيها. وفي نهاية المطاف، زودت الصين إيران بصواريخ باليستية قصيرة المدى، فضلا عن صواريخ كروز وصواريخ مضادة للسفن. وللتوضيح، لم تقتصر مساهمات بكين على البرنامج الباليستي الإيراني خلال تلك المرحلة، بل باعت أيضًا صواريخ باليستية متوسطة المدى من طراز DF-3 الى المملكة العربية السعودية عام ١٩٨٨.
ومع ذلك، سارعت إيران الى بناء صناعتها الدفاعية المحلية لتطوير وإنتاج الصواريخ. ونتيجةً لذلك، ظلّ حضور الصين محدودًا نسبيًا. وركّزت بكين بشكل أقل على بيع الأنظمة الجاهزة، مُركّزة على تزويد المجمع الصناعي العسكري الإيراني بالخبرة العلمية ومكونات مُحدّدة. وتحديدًا، ساعدت الصين المهندسين الإيرانيين على إحراز تقدّم في أنظمة الدفع والتوجيه لترسانتهم. ويُقدّر مُحلّلون عسكريون أن الصواريخ الباليستية الإيرانية، مثل شهاب-3 أو فاتح-110، اعتمدت على مكونات صينية. في الواقع، يُعتقد أن بعض الصواريخ التي نقلتها إيران الى حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن هي نسخٌ من صواريخ C-704 وC-802 الصينية. وفي مُقابل هذه المساعدة التقنية، حصلت الصين على إمدادات نفط إيرانية بسعر مُخفّض.
بالنسبة لأجهزة الاستخبارات الغربية، فأن طبيعة هذا التعاون تجعل كشفه أصعب بكثير من مجرد تصدير الأسلحة الجاهزة. كما أن نقل المعرفة أو التقنيات المزدوجة يجذب اهتمامًا أقل، مما يزيد من صعوبة رفع مستوى الوعي العام بهذه التبادلات. وأدانت الإدارات الأمريكية، بدءًا من رئاسة الرئيس السابق بيل كلينتون في التسعينيات، دعم بكين للبرنامج البالستي الإيراني، لكنه لم يُصبح قضية رئيسة على أجندة واشنطن.
يمكن للمرء أن يرد بأن هذه التطورات تعود الى ثلاثة عقود. إنها تتعلق بمرحلة، أوائل التسعينيات، عندما لم تكن الصين القوة العالمية التي هي عليها اليوم. لقد شوهت مذبحة ميدان تيانانمن عام 1989 صورة بكين الدولية، وكان انخراطها مع المجتمع الدولي أكثر محدودية. على سبيل المثال، لم توقع الصين (ولا تزال) على نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ، ولم تنضم الى معاهدة حظر الانتشار إلا عام 1992.
مع ذلك، تجدر الإشارة الى أن هذا التعاون الصاروخي بين الصين وإيران لم يتوقف تمامًا. في الواقع، في أواخر نيسان 2025 - قبل شهر واحد فقط من شن إسرائيل حملتها الجوية على إيران - أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية ست كيانات وستة أفراد صينيين مسؤولين عن تزويد الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) بـ "مكونات الدفع" المستخدمة لإنتاج الوقود الصلب اللازم لدفع الصواريخ الإيرانية. ومرة أخرى، نظرًا للطبيعة التقنية لتلك التبادلات، حظي البيان بتغطية إعلامية محدودة.
في ظل هذه الخلفية، لا تكشف أحدث التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نقطة تحول في تعامل الصين مع إيران، لكن توقيتها لا يزال مهمًا لعدة أسباب. أولًا، يُسلط الضوء على الحاجة الماسة لإيران لإعادة بناء ترسانتها بعد حرب الأيام الاثني عشر. قبل هجوم حماس في 7 /تشرين الأول 2023 على إسرائيل والصراع الإقليمي الذي تلاه، اعتمدت الاستراتيجية العسكرية الإيرانية على صواريخها الباليستية ومجموعتها من الوكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط (بما في ذلك حزب الله والحوثيون والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وغيرها)، كوسيلة ردع ضد إسرائيل. أما اليوم، فقد أضعفت العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة هؤلاء الشركاء غير الحكوميين الى حد كبير، ولم يعودوا قادرين على توفير العمق الاستراتيجي الذي كانت تتمتع به طهران سابقًا. ونتيجة لذلك، فأن الطريقة الأكثر فعالية للحرس الثوري الإيراني لاستعادة قوة ردع موثوقة ضد إسرائيل تمر بإعادة بناء مخزونه الصاروخي.
نظراً للأضرار التي ألحقتها الغارات الجوية الإسرائيلية بوحدات تخزين الصواريخ والمصانع، ستكون عملية إعادة تسليح طهران طويلة ومكلفة. ويشير خبراء مستقلون الى أن الأمر قد يستغرق عاماً على الأقل للوصول الى المستوى الذي سبق حرب الأيام الاثني عشر في حزيران الماضي. ولتحقيق ذلك، تحتاج إيران الى دعم خارجي، وروسيا هي الخيار الأوضح. فقد زودت موسكو إيران بأنظمة الدفاع الجوي منذ مدة طويلة، وقد تكثف التعاون العسكري بين موسكو وطهران في العامين الماضيين، اذ زودت إيران طائرات بدون طيار وطائرات مسيرة لدعم الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا. ومع ذلك، فقد استنزف الصراع المطول مع كييف معظم موارد روسيا، ولم تعد صناعتها الدفاعية قادرة على تلبية احتياجات إيران. ولذلك، فأن المجمع الصناعي العسكري الصيني في وضع أفضل لتلبية احتياجات الحرس الثوري الإيراني.
الى جانب قياس مدى التعاون الحالي بين بكين وطهران، فأن التوقيت مهم أيضاً لأنه يأتي في وقت تكثر فيه التكهنات بشأن حرب جديدة بين إسرائيل وإيران. ويُرسل الكشف عن تقييمات الاستخبارات الإسرائيلية رسالةً الى بكين مفادها أنه في ظلّ ما بعد 7 /تشرين الأول، لم تعد إسرائيل تتسامح مع مثل هذه الأنشطة، وقد تتصرّف بناءً عليها. ويهدف هذا الى إقناع الصين بالابتعاد عن عملية إعادة التسلح الإيرانية.
لا تستطيع إسرائيل بمفردها إكراه الصين، ومن غير المرجح أن تجعل الإدارة الأمريكية تعاون بكين الصاروخي مع إيران على رأس أولوياتها. ومع ذلك، هناك طرق يمكن لواشنطن من خلالها زيادة الضغط على الصين للابتعاد عن المشروع الباليستي الإيراني. في سياق المفاوضات التجارية الجارية بين بكين وواشنطن، قد يكون تعليق التعاون العسكري بين الصين وإيران شرطًا للشركات الصينية للوصول الى التقنيات الأمريكية، مثل رقائق إنفيديا الدقيقة.
إذا لم تحقق هذه المطالب، يمكن للولايات المتحدة أيضًا زيادة الدعاية لهذه الإجراءات الصينية تجاه شركائها في الشرق الأوسط، مثل دول الخليج. يُعدّ هذا الدعاية بمثابة تذكير مزعج بالأنشطة العسكرية الصينية في المنطقة. في عهد شي جين بينغ، أكد مسؤولو جمهورية الصين الشعبية باستمرار عدم رغبتهم في التورط في صراعات محلية، وأنهم لا يزودون الأطراف المتحاربة بالأسلحة. بدلًا من ذلك، تُفضّل الحكومة الصينية العلاقات القائمة على صفقات تجارية ذات منفعة متبادلة. وقد تحدثت ورقة السياسة العربية الصادرة عن بكين عام ٢٠١٦ عن "نتائج مربحة للجميع" وأدانت "التدخل الخارجي".
إن تاريخ مشاركة الصين في برامج الصواريخ في الخليج العربي يُقوّض هذه الرواية الإيجابية، ويُبرز تناقضات سياسة الصين الصاروخية في المنطقة. وتشير التقارير الى أن جهات صينية تدعم الإنتاج المحلي السعودي للصواريخ. في غضون ذلك، عرضت قطر صاروخًا باليستيًا صينيًا قصير المدى خلال عرضها العسكري بمناسبة يومها الوطني عام ٢٠١٧. قد تُسفر عمليات النقل هذه عن عواقب وخيمة. ففي عام ٢٠١٦، أصيبت سفينة تابعة للبحرية الإماراتية بصاروخ حوثي قدمته إيران، ومن المرجح جدًا أنه كان نسخة طبق الأصل من صاروخ صيني.
تُغذي سياسة الصين العشوائية في نقل الصواريخ سباق التسلح الإقليمي، وتؤثر في نهاية المطاف على مصالح الأمن القومي لحلفاء الولايات المتحدة، مثل إسرائيل ودول الخليج. ومع استمرار التهديد الحقيقي والمباشر باندلاع حرب جديدة بين إيران وإسرائيل، قد يتعين على الصين أن تسأل نفسها: هل يستحق الأمر الحفاظ على التعاون العسكري مع إيران على حساب دبلوماسيتها المعلنة "المربحة للجميع" في منطقة الخليج؟
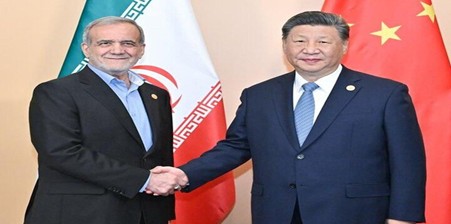
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!