بقلم: كارمن رنهارت (أستاذة في النظام المالي الدولي بكلية هارفارد كينيدي. وبعد الانتهاء من هذا المقال، تم تعيينها رئيسة الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي)، وفنسنت رنهارت (كبير الاقتصاديين وخبير الاستراتيجيات الكلية في Mellon).
الناشر: Foreign Affairs عدد (ايلول – تشرين الاول/ 2020) / واشنطن
ترجمة: د. حسين أحمد السرحان
مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
تشكل جائحة COVID-19 تهديدًا لجيل من سكان العالم. على الرغم من أن هذا ليس أول تفشٍ للمرض ينتشر في جميع أنحاء العالم، إلا أنه أول تفشي للمرض تقاومه الحكومات بشدة. جهود التخفيف -بما في ذلك عمليات الإغلاق وحظر السفر – حاولت إبطاء معدل العدوى للحفاظ على الموارد الطبية المتاحة. ولتمويل هذه الإجراءات وغيرها من تدابير الصحة العامة، استخدمت الحكومات في جميع أنحاء العالم قوة اقتصادية على نطاق نادرًا ما كنا نشهده من قبل.
على الرغم من تسميته بالأزمة المالية العالمية، فإن الانكماش الذي بدأ في عام 2008 كان الى حد كبير أزمة مصرفية في 11 اقتصادًا متقدمًا. أثبتت الأسواق الناشئة، بدعم من نمو مزدوج الرقم في الصين، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والميزانيات العمومية الهزيلة، أنها قادرة على الصمود تمامًا في وجه اضطرابات الأزمة العالمية الأخيرة. التباطؤ الاقتصادي الحالي مختلف. إن الطبيعة المشتركة لهذه الصدمة -فيروس كورونا الجديد لا يحترم الحدود الوطنية -وضعت نسبة أكبر من المجتمع العالمي في حالة ركود أكثر من أي وقت آخر منذ الكساد الكبير.
نتيجة لذلك، لن يكون الانتعاش قوياً أو سريعاً مثل الانكماش. وفي النهاية، ستعمل السياسات المالية والنقدية المستخدمة لمكافحة الانكماش على تخفيف الخسائر الاقتصادية بدلاً من القضاء عليها، مما يترك مدة زمنية طويلة قبل أن يعود الاقتصاد العالمي الى ما كان عليه في بداية عام 2020.
خلقت جائحة كوفيد 19 انكماشا اقتصاديا هائلا وسيكون متبوع بأزمة مالية في اجزاء عديدة من العالم، اذ تتراكم قروض الشركات المتعثرة جنبًا إلى جنب مع حالات الإفلاس. كما أن التخلف عن سداد الديون السيادية في العالم النامي مهيأ للارتفاع. ستتخذ هذه الأزمة مسارًا مشابهًا للأزمة التي اتخذتها الأزمة الأخيرة، باستثناء ما هو أسوأ، يتناسب مع حجم ونطاق الانهيار في النشاط الاقتصادي العالمي. وستلحق الأزمة الضرر بالأسر والبلدان ذات الدخل المنخفض بشكل أقوى من نظيراتها الأكثر ثراءً.
في الواقع، يقدر البنك الدولي أن ما يقارب 60 مليون شخص حول العالم سيساقون الى الفقر المدقع نتيجة لهذا الوباء. ونتيجة لذلك، يمكن توقع أن يسير الاقتصاد العالمي بشكل مختلف، اذ تنزلق الموازنات العمومية في العديد من البلدان بشكل أكبر الى المنطقة الحمراء وتتوقف مسيرة العولمة التي كانت لا هوادة فيها في يوم من الأيام.
تدهور جميع المحركات
في أحدث بيان له، توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2 في المائة في عام 2020. وقد نشر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي مؤخرًا أسوأ أرقام بطالة شهرية خلال الـ 72 عامًا التي سجلت فيها الوكالة بيانات البطالة. وتتوقع معظم التحليلات أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيظل بالقرب من نسبة مئوية تتكون من رقمين حتى منتصف العام المقبل (2021). وحذر بنك إنجلترا من أن المملكة المتحدة ستواجه هذا العام أكبر انخفاض في الإنتاج منذ عام 1706. وهذا الوضع مروع للغاية لدرجة أنه يستحق أن يطلق عليه الكساد -كساد الجائحة. ولسوء الحظ، منعت ذكرى الكساد العظيم الاقتصاديين وغيرهم من استخدام هذه الكلمة، حيث كان الانكماش في الثلاثينيات مؤلمًا بطريقة لا يحتمل تكرارها. لكن القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كان مليئًا بالاكتئاب. ويبدو من غير الاخلاقي أن يفقد الكثيرون وظائفهم ويغلقون أعمالهم لاستخدام مصطلح أقل حدة لوصف هذا البلاء.
يعتبر علماء الأوبئة أن الفيروس التاجي الذي يسبب COVID-19 أمرا جديدا؛ يترتب على انتشاره أثارة ردود افعال جديدة من الجهات الفاعلة العامة والخاصة على حد سواء. ويتضمن نهج الحد من انتشاره إبقاء العمال بعيدًا عن مصادر رزقهم والمتسوقين بعيدًا عن الأسواق. وبافتراض عدم وجود موجات ثانية أو ثالثة من النوع الذي كان عليه فايروس الإنفلونزا الإسبانية في 1918-1919، فإن هذا الوباء سيتبع منحنى مقلوب على شكل حرف V تزداد ثم تنخفض اعداد العدوى والوفيات فيه. ولكن حتى إذا حدث هذا السيناريو، فمن المحتمل أن يظل COVID-19 باقياً في بعض الأماكن حول العالم. وحتى الآن، لم يكن معدل الإصابة بالمرض متزامنًا. انخفض عدد الحالات الجديدة أولاً في الصين وأجزاء أخرى من آسيا، ثم في أوروبا، ثم بشكل تدريجي في أجزاء من الولايات المتحدة (قبل أن تبدأ في الارتفاع مرة أخرى في مناطق أخرى). في الوقت نفسه، ظهر انتشار COVID-19 في أماكن متميزة مثل البرازيل والهند وروسيا. في هذه الأزمة، تعتمد الاضطرابات الاقتصادية على انتشار المرض. وترك انتشاره سيشكل ندبة عميقة على النشاط الاقتصادي العالمي.
يتم الآن إعادة فتح بعض الاقتصادات المهمة، وهي حقيقة تنعكس في تحسن ظروف الأعمال في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وفي تحول في سوق العمل في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين هذا الارتداد والانتعاش. في جميع الأزمات المالية الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، استغرق الأمر ثماني سنوات في المتوسط حتى يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ما قبل الأزمة. (كان المتوسط سبع سنوات). مع المستويات التاريخية للتحفيز المالي والنقدي، يمكن للمرء أن يتوقع أن الولايات المتحدة ستكون أفضل حالًا. لكن معظم الدول لا تملك القدرة على تعويض الضرر الاقتصادي لفيروس كوفيد-19. الارتداد المستمر هو بداية رحلة طويلة من حفرة عميقة.
وعلى الرغم من أن أي نوع من التنبؤ في هذه البيئة سوف يتم إطلاقه من خلال عدم اليقين، إلا أن هناك ثلاثة مؤشرات تشير الى أن الطريق إلى التعافي سيكون طويلاً: الأول هو الصادرات، بسبب إغلاق الحدود وحضر التجول، تقلص الطلب العالمي على السلع، مما أصاب الاقتصادات المعتمدة على التصدير بشدة. حتى قبل الوباء، كان العديد من المصدرين يواجهون ضغوطًا. بين عامي 2008 و2018، انخفض نمو التجارة العالمية بمقدار النصف مقارنة بالعقد السابق.
في الآونة الاخيرة تضررت الصادرات بفعل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي أطلقها الرئيس الاميركي دونالد ترامب في اواسط عام 2018. وبالنسبة للصادرات التي تشكل فيها السياحة مصدر رئيس للنمو، كان التوقف في السفر الدولي ذو نتائج كارثية عليها. وتوقع صندوق النقد الدولي أنه في منطقة البحر الكاريبي، حيث تمثل السياحة ما بين 50 و90 في المائة من الدخل والتشغيل في بعض البلدان في المنطقة، فان عائدات السياحة ستعود إلى مستويات ما قبل الأزمة بشكل تدريجي فقط خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولم ينخفض حجم التجارة فقط، بل انهارت اسعار العديد من الصادرات، وظهر ذلك بشكل واضح في سوق النفط. وتسبب الكساد والتباطؤ بانخفاض كبير في الطلب على الطاقة، وفي انقسام التحالف الهش المعروف باسم (أوبك +)، المكون من أعضاء أوبك وروسيا ومنتجين آخرين متحالفين، والذين كانوا يوجهون أسعار النفط الى نطاق (45 الى 70 دولارًا للبرميل) خلال معظم السنوات الثلاث الماضية. وكان تحالف (أوبك +) قادر على التعاون عندما كان الطلب قويًا على النفط، وكان تعمل على اجراء تخفيضات ضرورية رمزية للإمدادات النفطية لتحافظ على الاسعار.
لكن هذا النوع من قطع الإمداد الذي تطلبه هذا الوباء كان من شأنه أن يتسبب في أن يتحمل اللاعبان الرئيسيان في المنظمة، روسيا والمملكة العربية السعودية، ألمًا حقيقيًا لم يكونوا مستعدين لتحمله. إن فائض الإنتاج الناتج عن ذلك والانخفاض الحر في أسعار النفط يختبر نماذج الأعمال لجميع المنتجين، ولا سيما في الأسواق الناشئة، بما في ذلك المنتج الموجود في الولايات المتحدة -قطاع النفط والغاز الصخري. وأدت الضغوط المالية المصاحبة إلى زيادة الحزن على كيانات ضعيفة بالفعل في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. على سبيل المثال، دخلت الإكوادور، التي تعتمد على النفط، في حالة التخلف عن السداد في نيسان 2020، ويتعرض منتجو النفط في الدول النامية لخطر كبير بأن يحذوا حذوها. في فترات الضائقة البارزة الأخرى، كانت الضربات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي جزئية فقط. فخلال أزمة ديون أمريكا اللاتينية التي دامت عقدًا من الزمن في أوائل الثمانينيات والأزمة المالية الآسيوية عام 1997، استمرت الاقتصادات الأكثر تقدمًا في النمو. وكانت الأسواق الناشئة، ولا سيما الصين، مصدرًا رئيسيًا للنمو خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008. لم تكون فترة الكساد العظيم آخر مرة تعطلت فيها جميع المحركات، وسيكون الانهيار هذه المرة مفاجئًا وحادًا بالمثل. وتقدر منظمة التجارة العالمية أن التجارة العالمية مهيأة للانخفاض بنسبة تتراوح بين 13 و32 في المائة في عام 2020. إذا كانت النتيجة في مكان ما ضمن هذا النطاق الواسع، فسيكون هذا أسوأ عام للعولمة منذ أوائل الثلاثينيات.
المؤشر الثاني الذي يشير إلى انتعاش طويل وبطيء هو البطالة. تعمل جهود التخفيف من الوباء على تفكيك أكثر الآلات تعقيدًا في التاريخ، وهو اقتصاد السوق الحديث، ولن يتم إعادة الأجزاء معًا بسرعة أو بسلاسة. لن يتم إعادة فتح بعض الأعمال التجارية المغلقة، وسيكون أصحابها قد استنفدوا مدخراتهم وقد يختارون موقفًا أكثر حذرًا فيما يتعلق بالمشاريع التجارية المستقبلية. وان معرفة طبقة رواد الأعمال لن يفيد الابتكار.
علاوة على ذلك، فإن بعض العمال المفصولين أو المبعدين سيخرجون من فئة القوى العاملة بشكل دائم. وسيفقد آخرون مهاراتهم ولا يمكنهم التمتع بفرص التطوير المهني خلال فترة البطالة الطويلة، مما يجعلهم أقل جاذبية لأصحاب العمل المحتملين. والأكثر ضعفا هم أولئك الذين قد لا يحصلون على وظيفة في المقام الأول -الخريجين الذين يدخلون في اقتصاد ضعيف. بعد كل شيء، يمكن تفسير أداء الأجور النسبي لمن هم في الأربعينيات والخمسينيات من العمر من خلال وضعهم الوظيفي خلال فترة المراهقة والعشرينيات، أولئك الذين يتعثرون عند بوابة البداية من مسار سباق العمل. وفي الوقت نفسه، يتلقى من لا يزالون في المدرسة تعليمًا دون المستوى في فصولهم الدراسية المتباعدة اجتماعيًا عبر الإنترنت؛ وفي البلدان التي يفتقر فيها الاتصال بالإنترنت أو يكون بطيئًا، يترك الطلاب الأفقر النظام التعليمي بأعداد كبيرة. ستكون هذه مجموعة أخرى ضمن الفئات المتروكة.
بالطبع السياسات الوطنية مهمة. اذ تدعم الاقتصادات الأوروبية الى حد كبير رواتب الموظفين غير القادرين على العمل أو الذين يعملون لساعات مخفضة، وبالتالي منع البطالة، في حين أن الولايات المتحدة لا تفعل ذلك. وفي الاقتصادات الناشئة، يعمل الناس في الغالب دون الكثير من شبكات الأمان. ولكن بغض النظر عن ثروتها النسبية، فان الحكومات تنفق أكثر وتستقبل أقل. العديد من الحكومات المحلية والإقليمية ملزمة بموجب القانون بالحفاظ على موازنة متوازنة، مما يعني أن الديون المتراكمة الآن ستؤدي الى التقشف لاحقًا. في غضون ذلك، تتكبد الحكومات المركزية خسائر حتى مع تقلص قواعدها الضريبية في البلدان التي تعتمد على الصادرات السلعية، والسياحة، وتحويلات المواطنين العاملين في الخارج، فهي تواجه أقوى رياح اقتصادية معاكسة.
ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الكساد جاء في وقت كانت فيه الأساسيات الاقتصادية في العديد من البلدان -بما في ذلك العديد من أفقر دول العالم -تضعف بالفعل. كنتيجة جزئية لعدم الاستقرار السابق، خفضت وكالات التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للمقترضين السياديين هذا العام أكثر من أي عام منذ عام 1980. وحتى تلك الدول التي تدير مواردها بحكمة قد تجد نفسها تحت الماء.
الميزة الثالثة البارزة لهذه الأزمة هي أنها رجعية للغاية داخل البلدان وعبر البلدان. إن الاضطرابات الاقتصادية المستمرة تقع بشكل أكبر بكثير على ذوي الدخل المنخفض. هؤلاء الأشخاص عمومًا لا يملكون القدرة على العمل عن بُعد أو الموارد اللازمة للتغلب على أنفسهم عندما لا يعملون. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يعمل ما يقرب من نصف العمال في شركات صغيرة، إلى حد كبير في صناعة الخدمات، حيث الأجور منخفضة. قد تكون هذه الشركات الصغيرة هي الأكثر عرضة للإفلاس، خاصة وأن آثار الوباء على سلوك المستهلك قد تستمر لفترة أطول بكثير من عمليات الإغلاق الإلزامية.
في البلدان النامية، حيث شبكات الأمان غير متطورة أو غير موجودة، سيحدث الانخفاض في مستويات المعيشة في الغالب في أفقر شرائح المجتمع. يمكن أيضًا تضخيم الطبيعة التراجعية للوباء بسبب الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء، حيث يعطل المرض وعمليات الإغلاق سلاسل التوريد وأنماط هجرة العمالة الزراعية. حذرت الأمم المتحدة مؤخرًا من أن العالم يواجه أسوأ أزمة غذائية منذ 50 عامًا. في أفقر البلدان، يمثل الغذاء ما بين 40 إلى 60 في المائة من النفقات المرتبطة بالاستهلاك؛ كنسبة من دخلهم، ينفق الناس في البلدان منخفضة الدخل خمسة إلى ستة أضعاف ما ينفقه نظرائهم في الاقتصادات المتقدمة.
طريق الانتعاش
في النصف الثاني من عام 2020، مع السيطرة ببطء على أزمة الوباء، من المحتمل أن تكون هناك مكاسب مبهرة في النشاط الاقتصادي والتوظيف، مما يغذي التفاؤل في الأسواق المالية. ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي هذا التأثير الارتدادي الى الشفاء التام. حتى الاستجابة المستنيرة والمنسقة لسياسات الاقتصاد الكلي لا يمكنها بيع المنتجات التي لم يتم تصنيعها أو الخدمات التي لم يتم تقديمها مطلقًا.
حتى الآن، كانت الاستجابة المالية في جميع أنحاء العالم مستهدفة بشكل ضيق نسبيًا ومخطط لها على أنها مؤقتة. اذ أقر الكونجرس الأمريكي أربع جولات من تشريعات التحفيز في حوالي عدة أسابيع. لكن العديد من هذه الإجراءات إما لمرة واحدة أو لها تواريخ انتهاء صلاحية محددة مسبقًا. ولا شك أن سرعة الاستجابة كانت مدفوعة بحجم المشكلة وفجأتها، والتي لم توفر أيضًا للسياسيين فرصة لتنظيم تشريعات أكثر استجابة. تمثل الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة حصة كبيرة نسبيًا من الدعم المالي الذي يقدر بنحو 11 تريليون دولار والذي ضخته دول مجموعة العشرين في اقتصاداتها. مرة أخرى، يوفر الحجم الأكبر من التحفيز مساحة أكبر للمناورة لمواجهة كساد الجائحة. لقد طورت البلدان ذات الاقتصادات الأكبر خطط تحفيز أكثر طموحًا. وعلى النقيض من ذلك، فأن الحافز الإجمالي للأسواق الناشئة العشرة في مجموعة العشرين يقل بخمس نقاط مئوية عن نظرائهم في الاقتصادات المتقدمة. ولسوء الحظ، هذا يعني أن الاستجابة المعاكسة للدورة الاقتصادية ستكون أصغر في تلك الأماكن التي تضررت بشدة من الصدمة. ومع ذلك، فان التحفيز المالي في الاقتصادات المتقدمة أقل إثارة للإعجاب مما تشير إليه الأرقام الكبيرة. في مجموعة العشرين، أنفقت أستراليا والولايات المتحدة فقط أموالاً أكثر مما قدمته للشركات والأفراد في شكل قروض وأسهم وضمانات. التحفيز في الاقتصادات الأوروبية، على وجه الخصوص، يتعلق بالميزانيات العمومية للشركات الكبيرة أكثر من الإنفاق، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في تعويض صدمة الطلب.
كما حاولت البنوك المركزية تحفيز الاقتصاد العالمي المتباطئ. لم تكن تلك البنوك مقيدة أيديها بالفعل بقرارات سابقة لإبقاء أسعار الفائدة معلقة عند أدنى مستوياتها التاريخية -كما فعل بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي -خففت قبضتها على تدفق الأموال. ومن بين تلك المجموعة كانت البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك البرازيل وتشيلي وكولومبيا ومصر والهند وإندونيسيا وباكستان وجنوب إفريقيا وتركيا. في أوقات الشدة السابقة، كان المسؤولون في مثل هذه الأماكن غالبًا ما يذهبون في الاتجاه الآخر، حيث رفعوا أسعار الفائدة لمنع انخفاض سعر الصرف واحتواء التضخم، وبالتالي هروب رأس المال. ومن المفترض أن الصدمة المشتركة أدت الى تكافؤ الفرص، مما قلل من المخاوف بشأن هروب رأس المال الذي يصاحب عادةً انخفاض قيمة العملة وانخفاض أسعار الفائدة.
وبنفس القدر من الأهمية، كافحت البنوك المركزية بشكل يائس للحفاظ على التدفق المالي عن طريق ضخ احتياطيات العملات في النظام المصرفي وخفض متطلبات احتياطي البنوك الخاصة حتى يتمكن المدينون من تسديد المدفوعات بسهولة أكبر. على سبيل المثال، فعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كلا الأمرين، حيث ضاعف المبلغ الذي ضخه في الاقتصاد في أقل من شهرين ووضع نسبة الاحتياطي المطلوبة عند الصفر. منح مكانة الولايات المتحدة كجهة مُصدرة لعملة الاحتياطي العالمي الاحتياطي الفيدرالي مسؤولية فريدة لتوفير السيولة بالدولار على مستوى العالم. وقد فعلت ذلك من خلال ترتيب اتفاقيات مقايضة العملات مع تسعة بنوك مركزية أخرى. في غضون أسابيع قليلة من هذا القرار، اقترضت تلك المؤسسات الرسمية ما يقرب من نصف تريليون دولار لإقراض بنوكها المحلية.
ولعل الأمر الأكثر أهمية هو أن البنوك المركزية كانت قادرة على منع الشركات (ذات الاصول غير السائلة) مؤقتًا من الوقوع في الإفلاس. يمكن للبنك المركزي أن ينظر إلى ما وراء تقلبات السوق ويشتري الأصول غير السائلة حاليًا ولكن يبدو أن تلك الشركات قادرة على الوفاء بها. لقد استخدم محافظو البنوك المركزية جميع الصفحات تقريبًا من هذا الجزء من دليل اللعبة، مع أخذ مجموعة واسعة من الضمانات، بما في ذلك الديون الخاصة والبلدية. تشمل القائمة الطويلة للبنوك التي اعتمدت مثل هذه الإجراءات في العالم المتقدم -مثل بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي -بالإضافة إلى البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل كولومبيا وتشيلي، المجر والهند ولاوس والمكسيك وبولندا وتايلاند. بشكل أساسي، تحاول هذه البلدان بناء جسر فوق السيولة الحالية لاقتصاد المستقبل المتعافي.
تصرفت البنوك المركزية بقوة وبسرعة. لكن لماذا كان عليهم ذلك؟ ألم تكن الجهود التشريعية والتنظيمية التي أعقبت الأزمة المالية الأخيرة (2008) تهدف الى تخفيف الأزمة في المرة القادمة؟ إن دخول البنوك المركزية إلى مناطق بعيدة عن عملها هي نتيجة مباشرة لفشل المحاولات السابقة للمعالجة. بعد أزمة عام 2008، لم تفعل الحكومات شيئًا لتغيير تفضيلات المخاطرة والعودة للمستثمرين. وبدلاً من ذلك، جعلوا الأمر أكثر تكلفة بالنسبة للمجتمع المنظم -أي البنوك التجارية، وخاصة البنوك الكبيرة -لتلبية الطلب على القروض من خلال إدخال قيود على الرافعة المالية وجودة الأصول، واختبارات الإجهاد. وكانت نتيجة هذا الاتجاه ظهور بنوك الظل، وهي مجموعة من المؤسسات المالية غير المنظمة إلى حد كبير. تتعامل البنوك المركزية الآن مع أصول جديدة وأطراف مقابلة جديدة لأن السياسة العامة دفعت عن قصد البنوك التجارية التي كانت تدعم في السابق الشركات والحكومات ذات الاصول غير السائلة.
من المؤكد أن إجراءات البنوك المركزية قد أوقفت على ما يبدو التدهور المتراكم في أداء السوق مع تخفيضات أسعار الفائدة وضخ كميات هائلة من السيولة وشراء الأصول. لقد تم نسج التصرف بهذه الطريقة لتلافي فشل بنك الاحتياطي الفيدرالي في القيام بذلك كما في ثلاثينيات القرن الماضي، مما كان له تأثير مأساوي. ومع ذلك، فان النتيجة النهائية لهذه السياسات ربما تكون بعيدة عن أن تكون كافية لتعويض صدمة كبيرة مثل تلك التي يعيشها العالم الآن. كانت أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة بالفعل قبل انتشار الوباء. وعلى الرغم من كل الدولارات الأمريكية التي يوجهها الاحتياطي الفيدرالي إلى الخارج، فقد ارتفعت قيمة صرف الدولار بدلاً من أن تنخفض. إن إجراءات التحفيز النقدي هذه في حد ذاتها ليست كافية لتشجيع الأسر والشركات الى الإنفاق أكثر نظرا الى الضائقة الاقتصادية الحالية وعدم اليقين. ونتيجة لذلك، فإن أهم محافظي البنوك المركزية في العالم — هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان؛ كريستين لاغارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي؛ وجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي -يحثون الحكومات على تنفيذ تدابير تحفيز مالية إضافية. لقد تم تلبية مناشداتهم، ولكن بشكل غير كامل، لذلك كان هناك انخفاض هائل في النشاط الاقتصادي العالمي.
الاقتصاد ومتاعبه
سيكون ظل هذه الأزمة طويلاً ومظلمًا -أكثر من ظل العديد من الأزمات السابقة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتضخم نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة من 3.3٪ في 2019 إلى 16.6٪ هذا العام، وفي الأسواق الناشئة، سترتفع من 4.9٪ إلى 10.6٪ خلال نفس الفترة. تحذو العديد من البلدان النامية حذو نظيراتها المتقدمة في فتح صنبور المالية العامة. ولكن بين الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، تفتقر العديد من الحكومات إلى الحيز المالي للقيام بذلك. والنتيجة هي عدة ميزانيات حكومية ممتدة فوق طاقتها (زيادة النفقات على حساب الايرادات وهو عجز مؤكد).
التعامل مع هذا الدين سيعيق إعادة البناء. لقد أجلت مجموعة العشرين بالفعل مدفوعات خدمة الديون لـ 76 دولة من أفقر البلدان. سيتعين على الحكومات الأكثر ثراءً ومؤسسات الإقراض بذل المزيد من الجهد في الأشهر المقبلة، وإدماج الاقتصادات الأخرى في خططها لتخفيف الديون وإشراك القطاع الخاص. لكن الإرادة السياسية لاتخاذ هذه الإجراءات قد تكون مفقودة إذا قررت البلدان التحول إلى الداخل بدلاً من دعم الاقتصاد العالمي.
لقد اهتزت العولمة لأول مرة مع وصول إدارة ترامب في عام 2016. وسوف تزداد سرعة التراجع فقط عندما يتم إلقاء اللوم على الفوضى الحالية. ويبدو أن الحدود المفتوحة تسهل انتشار العدوى، وأن الاعتماد على أسواق التصدير يجر الاقتصاد المحلي الى أسفل عندما يتضاءل حجم التجارة العالمية. وشهدت العديد من الأسواق الناشئة انهيار أسعار سلعها الأساسية وانهيار التحويلات من مواطنيها في الخارج. المشاعر العامة مهمة للاقتصاد. بشكل عام، الثقة -عامل التسهيل الرئيس لمعاملات السوق -تعاني من نقص عل المستوى الدولي. وسيكون من الصعب عبور العديد من الحدود، وستتفاقم الشكوك حول مصداقية بعض الشركاء الأجانب.
هناك سبب آخر لتعثر التعاون العالمي وهو أن صانعي السياسة قد يخلطون بين الانتعاش قصير الأجل والانتعاش الدائم. يعد وقف الانحدار في الدخل والإنتاج إنجازًا حاسمًا، ولكن أيضًا سيعجل الانتعاش. كلما استغرق الأمر وقتًا أطول للخروج من الحفرة التي أحدثها هذا الوباء في الاقتصاد العالمي، كلما طالت مدة تعطل بعض الناس عن العمل بلا داع، وزادت احتمالية إعاقة آفاق النمو على المدى المتوسط والطويل بشكل دائم.
العواقب الاقتصادية مباشرة للجائحة. ومع انخفاض الدخل في المستقبل، تصبح أعباء الديون أكثر صعوبة. ومن الصعب التنبؤ بالعواقب الاجتماعية. ينطوي اقتصاد السوق على صفقة بين مواطنيه: سيتم استخدام الموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة لجعل الفطيرة الاقتصادية (اي القدرة الاقتصادية -المترجم) أكبر حجم ممكن وزيادة فرصة نموها بمرور الوقت. وعندما تتغير الظروف نتيجة للتقدم التكنولوجي أو فتح طرق التجارة الدولية، تتغير الموارد، مما يخلق رابحين وخاسرين. طالما أن القدرة الاقتصادية تتوسع بسرعة، يمكن للخاسرين أن يشعروا بالراحة في حقيقة أن الحجم المطلق لشرائحهم لا يزال ينمو. على سبيل المثال، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4٪ سنويًا، وهو المعيار السائد بين الاقتصادات المتقدمة في أواخر القرن الماضي، يعني ضمناً مضاعفة الإنتاج في 18 عامًا. إذا كان النمو واحد في المائة، وهو المستوى الذي ساد في ظل الركود الاقتصادي في الفترة 2008-2009، فان الوقت الذي يستغرقه مضاعفة الإنتاج يمتد الى 72 عامًا. مع التكاليف الحالية الواضحة وتراجع الفوائد إلى أفق أبعد، قد يبدأ الناس في إعادة التفكير في صفقة السوق (سياسات اقتصاد السوق).
أشار المؤرخ هنري آدامز ذات مرة الى أن السياسة تدور حول التنظيم المنهجي للكراهية. فالناخبون الذين فقدوا وظائفهم وشاهدوا أعمالهم تغلق واستنفدت مدخراتهم غاضبون، ليس هناك ما يضمن أن يتم توجيه هذا الغضب في اتجاه مثمر من قبل الطبقة السياسية الحالية -أو من قبل أولئك الذين سيتبعونها إذا تم التصويت على السياسيين في السلطة. غالبًا ما يرتفع مد القومية الشعبوية عندما ينحسر الاقتصاد، لذلك من شبه المؤكد أن يزداد انعدام الثقة بين المجتمع العالمي. وسيؤدي ذلك إلى تسريع تدهور التعددية وقد يخلق حلقة مفرغة من خلال زيادة خفض الآفاق الاقتصادية المستقبلية. هذا هو بالضبط ما حدث بين الحربين العالميتين، عندما ازدهرت السياسات القومية وسياسة إفقار الجار.
لا يوجد حل واحد يناسب الجميع لهذه المشاكل السياسية والاجتماعية. لكن أحد الإجراءات الحكيمة هو الحيلولة دون تفاقم الظروف الاقتصادية التي أنتجت هذه الضغوط. يحتاج المسؤولون الى الضغط على الحوافز المالية والنقدية. وفوق كل شيء، يجب عليهم الامتناع عن الخلط بين الانتعاش من أجل انتعاش قصير الاجل، والانتعاش من اجل انتعاش طويل الاجل.
رابط المقال الاصلي:
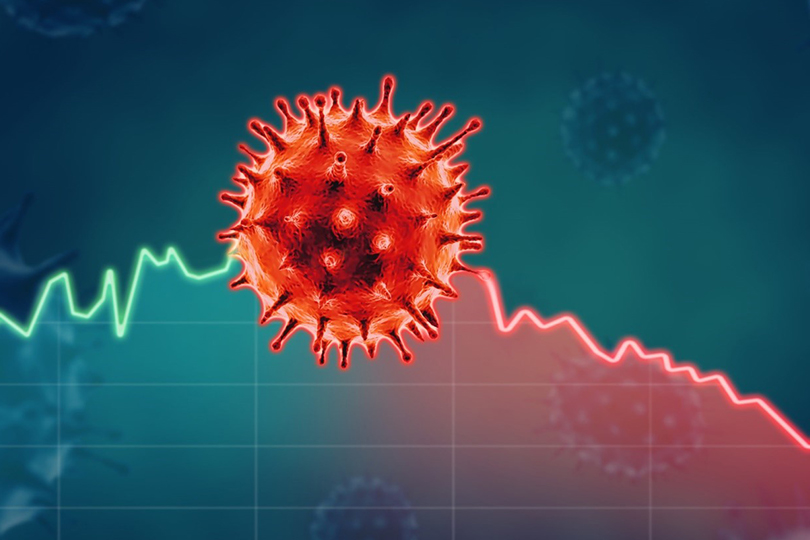
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!