ليس امام هذا الخطاب من سبيل للنجاة من الانحدار والزوال، الا البدء بسرعة بإعادة النظر في منطلقاته الفكرية والعملية، من اجل تجديدها وتقديم خطاب مختلف ينسجم مع حاجات العصر، وقادر على الاستجابة لتطلعات الشعوب المسلمة وغير المسلمة في العالم الإسلامي، وان السبل الى ذلك ستكون موضع المقال الثالث لهذه السلسلة
المقال الثاني-انعكاس العوامل المؤثرة على المنظومة الفكرية والسلوكية للخطاب الإسلامي
بقلم: الأستاذ الدكتور خالد عليوي العرداوي
آذار-مارس 2024
أشرنا في المقال الأول من هذه السلسلة الثلاثية الى ان الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر الذي نراه سائدا اليوم في العراق، وبقية العالم الإسلامي، وقع في مرحلته التأسيسية قبل أكثر من قرنين تحت تأثير أربع عوامل مهمة، هي: صدمة الغرب الحديث، الصراع مع الأنظمة الحاكمة المستبدة، أرث الماضي، ووصاية الخط العقائدي-الفقهي على الخط السياسي، وقد افضنا في وقته بما تضمنته هذه العوامل من مظاهر وتحديات.
وفي هذا المقال سيجري التركيز على تأثيرات العوامل أعلاه على المنظومة الفكرية والسلوكية لمعظم القوى الإسلامية، لاسيما العراقية التي حملت لواء هذا الخطاب، وخاصة تلك القوى التي وصلت الى سدة الحكم، وتولت زمام القيادة الكاملة او الجزئية في بلدانها.
لقد ظهر جليا ان العوامل المؤثرة في المرحلة التأسيسية اثرت بشكل عميق ومباشر في الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر، وبرزت هذه التأثيرات من خلال ما يلي:
1-تضخم الميثولوجيا الدينية والتطرف تجاه الآخر.
تعرف الميثولوجيا بأنها علم الاساطير، وفي الاغلب ترتبط هذه الاساطير بالسرديات الدينية، التي تجعل مسار الاحداث ومآلاتها محددة سلفا من قبل السماء، فتغدو الإرادة البشرية في صناعة الاحداث والتحكم بمصير الانسان محدودة للغاية ان لم تكن مستبعدة نهائيا.
ان الميثولوجيا تنشط كثيرا في المجتمعات البدائية التي تفتقر للمعرفة الكافية بنفسها وما يحيط بها، فيدفعها جهلها الى التركيز على القوى الغيبية، منتظرة منها كشف الاسرار الغامضة او تحديد مسارات الاحداث الخارجة عن سيطرتها. كما تنشط الميثولوجيا في المجتمعات الضعيفة التي تعرضت طويلا للقهر والنهب والاستعباد، وعجزت خلال ذلك عن وضع حد للظلم الواقع عليها.
واذا اخذنا هذين السببين مع بعض واسقطناهما على وضع المجتمع العراقي وغيره من المجتمعات المسلمة، سنجد ان طول الصراع مع الغرب، وما الحقته سياساته الاستعمارية في القرنين الاخيرين من اضرار على الانسان والأرض والثقافة في هذه المجتمعات قد ترك بصماته الواضحة في استمرار تخلفها الحضاري من جهة، وتنامي شعورها بالظلم الواقع عليها من خارجها من جهة أخرى، فارتدت تبحث عن هويتها الثقافة الخاصة، كما اسلفنا ذكره في المقال الاول، وبحثها عن هذه الهوية صاحبه تمحور متزايد حول الذات المسلمة، ومحاولة لا لبس فيها لإظهار ان ما تواجهه من تحديات انما هو جزء من مخطط سماوي هدفه تحضيرها لاستلام قيادة العالم من جديد.
وفي ظل هذا التوجه ستتخلى الذات المسلمة عن نقد نفسها كليا او جزئيا، وحتى النقد في حالة وجوده فهو نقد موجه –غالبا-لعدم بلوغها استحقاقها المخطط له سماويا، لا نقد يحملها مسؤولية قراراتها الخاطئة وفشلها في إدارة دولها ومجتمعاتها، بل ان الفشل نفسه يصبح مجرد امتحان لتدريب الافراد والقوى السياسية وتأهيلهم للدور المطلوب منهم، أي انه ليس فشلا يحتم عليهم الانسحاب وترك الساحة الى من هو أفضل وأكفء، فالأفضلية والكفاءة محسومة لهم لا لغيرهم في جميع الأحوال، هذا من جانب.
ومن جانب آخر سوف يصبح الفرد جندي الله، والحركة التي ينتمي اليه هي حركة الله، والمعارك السياسية والعسكرية التي يخوضها هي معارك دينية تجري بقيادة ألهية، قررتها مسبقا السماء وفرضت خوضها حتى النهاية، لا مجرد صراعات إنسانية طبيعية تضطر اليها المجتمعات غالبا من اجل نيل حقوقها وحرياتها، والحفاظ على كرامتها في ظل بيئة يتحكم بها البشر ظالمين كانوا ام مظلومين.
وتبرز انعكاسات التضخم الميثولوجي الديني لدى اطراف الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر في اطروحاتهم المتعددة سواء تلك المرتبطة في استعادة مجد الخلافة الإسلامية بثوبيها الاخواني والسلفي، لا سيما ما طرحته السلفية الجهادية من مواقف متطرفة عند خوضها لصراعاتها مع خصومها المحليين والدوليين بحجة التحضير لمعركة نهاية العالم (هرمجدون او دابق)، كما تجد أمثال ذلك في الاطروحات الشيعية التي تدور حول نظرية المهدي المنتظر، وحرب السفياني، وإقامة العاصمة العالمية في الكوفة، وما يرتبط بها من اراء لحركات مختلفة اضفت على نفسها ثوب الطهرانية لتمهيد المنتمين لها للظهور المرتقب، وخوض الحروب السماوية المتوقعة مع الأعداء.
ان الميثولوجيا الدينية ليست امرا جديدا في حياة الشعوب، فكل المجتمعات حتى المتقدمة منها تعيش تحت وطئتها بشكل ام آخر، ولكنها في الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر برزت بشكل مبالغ فيه، وحققت لقيادات الحركات الإسلامية فوائد كثيرة، فهي حررتهم في كثير من الأحيان من عبأ تحمل مسؤولية الأخطاء الناتجة عن قراراتهم ذات البعد البشري الصرف المرتبط بالسلطة وصراعاتها، وضمنت لهم طاعة اتباعهم وسكوتهم حتى النهاية، او على الأقل الى المستوى الذي لا يشكلون فيه ضررا حقيقيا عليهم، ومنحتهم مبررات كثيرة لتفسير عدم تقدم بلدانهم وتأخرها حضاريا بحجة ان معاناتها وبؤسها لم يحن وقت نهايتها، وان ازدهارها وسعادتها لا زالت تنتظرها وتنتظر الأجيال القادمة، عندما تحين الساعة المقررة ضمن المخطط الإلهي.
لقد رفع الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر مسؤولية الفشل والتأخر عن عاتق القيادات والحركات الإسلامية المعاصرة، والقاها على عاتق الشعوب المسلمة، لأنها لم تكن مستعدة لحمل الاطروحة الإسلامية، ولم تقم بواجبها المطلوب، كما ارجعها بشكل من الاشكال الى الله، بحجة ان المخطط الإلهي غير محدد التوقيتات ولا يمكن الجزم به، وتأخره حتى لو طال الى الاف السنين سيقترن معه استمرار البؤس والمعاناة لهذه الشعوب.
خلاصة القول في هذا الامر: لقد منح تضخم الميثولوجيا الدينية بعض القيادات والحركات والمجتمعات الإسلامية إحساسا كبيرا بالاتكالية على منقذي السماء والمخططات الالهية، وقلل قوة الفعل الإنساني المبدع والخلاق ليقرر الانسان المسلم مصيره بنفسه، وكان شماعة او حجة يسهل الاتكاء عليها لتبرير الإخفاق والفشل، بل والسماح باستمراره الى أمد غير منظور.
ومع تضخم الميثولوجيا الدينية المطهرة للذات او المتهاونة مع قصورها، برزت ظاهرة العداء الى الاخر سواء بصورة جلية واضحة من خلال الفتاوى الصريحة ام بصورة خفية مستترة تجدها في طيات الكتب وبين السطور. والأخر هنا سيصبح اما عدوا لا يمكن قبوله والتعايش معه، واما عدوا يجري التعاون معه على مضض لأسباب تكتيكية مرحلية وليست استراتيجية دائمة.
كما أن الآخر ربما يكون اجنبيا عن الذات ولا يتشارك العيش معها، فيتم اتهامه وتكفيره وتفسيقه، ووصم كل ما يرتبط به بالنفور والرفض سواء كانت قيما ام مؤسسات ام قوانين ومواقف سياسية وانماط حياة، لذا يجري استحضار مقولات دار الكفر من التراث للصقها به بطريقة منحازة ضده بعيدا عن الموضوعية –غالبا-ومبررة لكراهيته، وغالبا ما يكون المقصود بهذا العدو هو الغرب. ولا غرابة في ذلك فالميراث الثقافي التصارعي بين العالم الإسلامي والعالم الغربي لا زال حاضرا بقوة لدى الجانبين للأسف، على المستوى السياسي على الأقل، وسياسات الغرب العدائية وغير العادلة في القرنين الأخيرين اتجاه المسلمين وقضاياهم المهمة وهويتهم الثقافية تساعد كثيرا على هذا الامر.
ولكن العداء للأخر لا يقتصر على الأجنبي، بل اشتد وزاد-أيضا-للشريك المحلي شريك الوطن، وشريك الدين والمذهب، ولذا تجد في ذروة الصحوة الإسلامية برزت مقولات التكفير والفتاوى المتطرفة اتجاه هذا الشريك، مرة بنعته بالجاهلي، وثانية بالرافضي، وثالثة بالناصبي، وهكذا دواليك، فكل ما لا يتطابق مع الذات سيصبح عدوا، يستباح –أحيانا-دمه، وماله، وعرضه، ولا يستحق ان يُحافظ على كرامته...نعم قد تختلف مستويات التطرف في هذه المواقف بين حركة وأخرى واتجاه إسلامي وآخر، ولكن على العموم تجد انها موجودة لدى الجميع بدرجة او أخرى.
وما شهده العراق وعدد من البلدان الإسلامية في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين من احداث مروعة في صراع الإسلاميين فيما بينهم وبينهم وبين خصومهم الاخرين انما يدل بما لا يقبل الشك على وجود مشكلة لديهم في تصور الآخر سواء كان اجنبيا ام محليا، فغالبا ما كانت هذه الاحداث تتم بمباركة فتاوى يصدرها شيوخ وأئمة مساجد ومبلغين دينيين، ويجري تسويقها الى الرأي العام المحلي والدولي باسم الجهاد في سبيل الله.
2-عقلية المعارضة ومحاكاة مناهج الحكام السابقين في الحكم.
ان دراسة الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر هي جزء من دراسة علاقة السلطة في بلداننا الإسلامية مع شعوبها، وهي علاقة لم تكن على ما يرام على طول الطريق، فالسلطة –غالبا-مستبدة، ضيقة الأفق، ولا تتحمل الآخر المعارض. فيما الشعوب لا تحمد أداء السلطة، ولا تثق بالحكام، وتشعر بالخيبة تجاههم، وتعاني الظلم وانعدام العدالة على أيديهم.
وهذه العلاقة المتأزمة بين السلطة وشعبها ليست وليدة الوقت الحاضر، وانما هي تمتد لقرون طويلة، منذ ان أصبح الحكم في بلاد المسلمين ملكا عضوضا تتوارثه الاسر الحاكمة، ويوظف لخدمة ملذاتها، على حساب حقوق وحريات المحكومين، ولم تشهد خلالها بلاد المسلمين انتقالا سلميا للسلطة من حاكم قديم الى حاكم جديد لا ينتمي لأسرة الحاكم الهالك او دائرة حكمه، بل كان الانتقال إذا ما حصل انما يحصل بقوة السيف والدم.
ونتيجة ذلك كانت أن أي معارضة للسلطة انما هي مغامرة خطرة على من يقوم بها، ولكن تنوع البشر واختلاف معتقداتهم ومصالحهم ورؤيتهم لإدارة شؤونهم الخاصة والعامة يحتم المعارضة مهما كانت شدة بأس السلطة وجبروتها، ولذا زخر تاريخ المسلمين بحركات معارضة عديدة في الماضي خاضت صراعات ملحمية مع السلطة القائمة، بعضها فشل في تحقيق أهدافه فتم التنكيل بدعاته بمنتهى القسوة، وبعضها الآخر نجح وأمسك زمام السلطة فنكل –أيضا- بقسوة برموز السلطة البائدة واتباعها، واختط له طريقا جديدا في الحكم يختلف في شخوص الحكام، ولكنه يكرر باستمرار تلك العلاقة المأزومة للسلطة مع شعبها دون اتعاظ.
هذا الميراث الطويل من الثقافة المنحدرة لأنظمة الحكم في بلداننا الإسلامية لم يتوقف عند وصولها الى العصور الحديثة والمعاصرة، بل استمر وعانت منه تيارات المعارضة السياسية أي كانت توجهاتها الفكرية، سواء كانت شيوعية ام قومية ام ليبرالية ام إسلامية، ويكفي للإشارة اليها تذكر حجم المعاناة التي تكبدها المعارضون وعوائلهم في سجون الأنظمة الحاكمة، ومصادرتها لأملاكهم، والتضييق عليهم بشكل مبالغ وصولا الى اعدام الكثير منهم، بمحاكمات صورية غير عادلة او من خلال الاغتيالات والمقابر الجماعية.
لقد واجه الإسلاميون كمعارضة سياسية لأنظمة الحكم في العراق وغيره ما واجهه اسلافهم من المعارضين في بلدانهم، وعانوا مثل ما عانوه، على ايدي حكام مختلفين يحملون نفس النظرة الضيقة المستبدة للآخر المعارض، في ظل ثقافة سياسية متشابهة الى حد ما، ولذلك تغلغلت في عقولهم مبتنيات هذه الثقافة واسسها القيمية والسلوكية، فبلداننا لم تتعود كثيرا على الانفتاح داخلها على الرأي والرأي الاخر، وتجارب الانفتاح الفاشلة والناشئة في قرنها الأخير لا تستطيع ان تمحو بسهولة ميراثا ثقافيا عمره اكثر من الف عام سمته الأساسية الاستبداد والحكم بالسوط والسيف.
لقد عانى الإسلاميون العراقيون وغيرهم من وطئة ثقافتهم السائدة المنغلقة، ومن شعورهم بكونهم معارضة سياسية غير مرحب بها من الأنظمة الحاكمة وتخوض معها صراعا وجوديا اكثر منه تنافسا سياسيا حول إدارة السلطة وتحقيق مصالح الدولة والمجتمع، واستحكمت عقلية المعارضة بهم قيميا وسلوكيا حتى باتت جزء لا يتجزأ من عاداتهم وتقاليدهم، فهم لا يأمنون السلطة حتى عندما يكونوا هم قادتها، ولا يثقون بانتصارهم حتى عندما تحسمه الاحداث، وتنغلق دوائر انفتاحهم على غيرهم من الافراد والأفكار بسبب ما اعتادوا عليه من حياة سرية مغلقة حتمتها عليهم ظروف المعارضة، ولا يدركون قوتهم الذاتية-وهذا شأن أي معارضة سياسية تخوض صراعا مع نظام مستبد قاسي- فتجدهم يبحثون عن مصدر قوة خارجي لحمايتهم والانتصار لهم عند الضرورة.
ولا يقتصر الامر على ما تقدم، بل انهم استمروا في النظر لأنفسهم كمعارضة تعيش في ظروف صراع مع مجتمعها ونظام حكمه، وفي نفس الوقت تخاف منهما على نفسها، فتدير السلطة في الغرف المغلقة، وتتحرك فيها بعقلية التآمر وما تسميه مقتضيات ظروف الاستمكان منها.
إضافة الى ما تقدم تجد –أيضا-انهم عند وصولهم الى السلطة في العراق ومصر وليبيا وغيرها من البلدان الإسلامية كرروا أخطاء الحكام السابقين في طريقة إدارة السلطة والنظر الى المعارضة، فمارسوا التصفية لرموز السلطة السابقة، وضيق الأفق مع الرأي الاخر، لاسيما عندما يشعرون بالتهديد لبقائهم في الحكم.
ولذا كان خطابهم ينوء تحت ضاغطين مباشرين:
الأول-استمرارهم بالعمل بعقلية المعارضة سواء بشعور منهم او عدم شعور.
والثاني-استحضارهم قيم وممارسات الأنظمة التي قمعتهم بعدما أصبحوا هم الحاكمين.
هذان الضاغطان تسببا بالإرباك الشديد في خطابهم: فالأول منهما منعهم من الانتقال من مرحلة المعارضة: بدسائسها، ومكائدها، وادواتها الصلبة، وضروراتها المرحلية، الى مرحلة جديدة يكونوا فيها بناة الدولة وقادتها المسؤولين عن تعزيز قانونها، ومؤسساتها، وحماية مصالحها، وكرامة مواطنيها، وصيانة سيادتها. لقد استمروا بالتصرف كمعارضة تتصارع من اجل اثبات الوجود مع الجميع، حتى مع شركائهم السياسيين، لا كرجال دولة يؤسسون لمنهج جديد في القيادة والحكم والإدارة. اما الضاغط الثاني، فانه حال بينهم وبين تحقيق وعودهم التي أطلقوها لشعوبهم في تشكيل الدولة الفاضلة العادلة التي لا تظلم الناس، ولا تعتدي على حقوقهم وحرياتهم العامة، وتختار حكامها من بين أكفأ المواطنين وأقدرهم على حمل الأمانة وصيانة المسؤولية.
ان استفحال ثقافة الاستبداد في المجتمع ومؤسسات الدولة، وضعف القدرات القيادية للإسلاميين في بناء نموذجهم الجاذب الجديد في الحكم، ومجابهة التحديات التي تعصف بهم جعلتهم نسخة مكررة من أنظمة الحكم التقليدية في بلدانهم، بل أحيانا أسوء عندما اقترن سوء الأداء والفساد في الحكم بالفوضى وغياب القانون، وهذا الامر جعلهم يخسرون ثقة الناس بهم، وزادت الفجوة بين الطرفين مع طول مدة ادارتهم غير الموفقة، واستمرار ذلك سيعني في الأخير نهايتهم وأفولهم كما انتهى غيرهم من الحكام والطروحات، ففقدان الثقة الشعبية بأي أطروحة مهما كانت وعودها جذابة، وأي حاكم مهما كانت نواياه حسنة كفيلة لوحدها بالحكم عليه بالزوال ولو بعد حين.
3-النزعة الطائفية.
عندما نتكلم عن ارث الماضي الثقافي، فإننا لا نتكلم عن ارث سياسي عنيف وغير ديمقراطي فقط، بل نتكلم عن ارث ديني مليء بالصراع حول الحقيقة التاريخية والعقائدية في الوقت نفسه، ارث كان فيه الاحتجاج الصدامي بين أصحاب الأديان والمذاهب المختلفة أمرا طبيعيا للغاية، وجرى فيه توظيف علوم الفقه والأصول والكلام ومختلف اشكال الغيبيات والميثولوجيا لأثبات ان هذا الطرف على صواب وغيره على خطأ، تحت غطاء الفرقة الناجية، وقد زاد الصراع السياسي من حدة الصراع العقائدي الديني، بل انه كان العامل المحرض على تأجيجه واستعاره وقطع جسور التفاهم والتلاقي بين اطرافه، وكان الحديث عن الفرقة الناجية حديثا عاما، بصرف النظر عن صحة سند هذا الحديث، حاله حال الكثير غيره من الاحاديث الضعيفة او الموضوعة والمحرفة لخدمة اهداف ومصالح معينة في وقتها، ولكن جرى ترويجها لفائدتها في حماية وتحقيق هذه الأهداف والمصالح جيلا بعد جيل.
أقول: ان تاريخ المسلمين الماضي، وعلى الرغم من الصفحات المشرقة التي انطوى عليها يوما ما في التجديد الفكري والديني والحضاري، الا انهم واجهوا ما واجهه اتباع كل الأديان من انقسامات عقائدية شديدة للغاية، ترتب عليها صراعات مؤسفة ضُربت فيها الرقاب، وانتهكت الحرمات، وطُمست حقائق وُسوقت حقائق غيرها مزيفة أحيانا، وتحول ابطال هذه الصراعات مع مرور الزمن وطول مدته الى رموز مقدسة هي جزء لا يتجزأ من الحقيقة التاريخية نفسها، وبسبب الاستبداد السياسي وشدة الانقسام العقائدي انغلقت المذاهب على رموزها وحقائقها التاريخية، وصار مجرد الاقتراب منها بالمراجعة والتغيير او النقد كفيلا بإشعال الفتن الشديدة التي لا يمكن اخمادها بسهولة، فانشغل أبناء كل مذهب بالدفاع عن رموزهم وحقائقهم، وصار ذلك من مقتضيات جهادهم في سبيل الله، وتأكيد هويتهم وثباتهم على ميراث الإباء والاجداد غير القابل للنقاش او المساومة، بل أن صعودهم اجتماعيا وسياسيا اقترن-في كثير من الأحيان- بمقدار هذا الثبات وشدته.
لقد استمر هذا حال المسلمين في بلدانهم المختلفة، وكل بلد من هذه البلدان يتناسب استقراره سياسيا واجتماعيا وأمنيا طرديا مع مقدار انسجامه ثقافيا من الناحية العقائدية، فكلما كان أبناء مذهب من المذاهب هم الأكثرية الغالبة في ذلك البلد، كلما كان أكثر استقرارا والعكس صحيح، فالبلدان الأكثر تنوعا من الناحية العقائدية تزداد فيها القلاقل والصراعات كما هو الحال في العراق وامثاله من البلدان.
ان انتقال المسلمين بحالهم هذا من العصور الوسطى الى العصور الحديثة والمعاصرة ترافق مع ظروف تقهقرهم الحضاري وتسابق الأمم غير الإسلامية على احتلالهم والتحكم بمصيرهم او تقرير اتجاهاته، فأصبح حنينهم الى الماضي المجيد النقي الايمان يتناغم مع تشددهم الطائفي وحلمهم الميثولوجي باستعادة مجدهم المفقود في المستقبل، وهما تشدد وحلم يختلف في تصوراته وادواته من طائفة الى أخرى.
وفي ظل هذه الظروف برزت الحركات الإسلامية المعاصرة، وبدأ أصحابها يفكرون ويعملون لتغيير أوضاع بلدانهم وقيادتها انطلاقا من اطروحات مختلفة حسب اختلاف اصولهم العقائدية المذهبية، وهي طروحات ربما تنجح في البلدان ذات الأغلبية الطائفية عندما تكون الغلبة المطلقة فيها لطائفة ما، ولكنها تتصادم وتتقاطع سبلها في البلدان المتنوعة، كالعراق، ويغدو تحركها السياسي في مثل هذه البيئات مجرد تحرك نحو المزيد من استحضار رموز الماضي وحقائقه غير القابلة للنقاش، وسيكون صراعها في القرن الحادي والعشرين مشحون بكلمات واحتجاجات وتصورات موروثة من زمن الامويين والعباسيين ومن جاء بعدهم، بل يصبح صراعهم اليوم مجرد امتداد لصراع آبائهم وأجدادهم في الماضي بعد ان يجري تغييب مقصود وانتزاع غير موضوعي لحقيقة التغير في الزمان، وظروفه، والأسباب الكامنة وراء احداثه.
وفي مثل هذه البيئة المعبئة طائفيا يتصاعد نجم القيادات والزعامات التي تظهر بمظهر التشدد والتصلب من الناحية الطائفية، والتي ينحصر همها الأساس بالدفاع عن أبناء طائفتها، بصرف النظر عن الحقوق والحريات المتساوية لبقية الناس في دولها، ويوظف العزف على الوتر الطائفي لتحقيق المزيد من المكاسب والمغانم في السلطة والمجتمع، ويصبح الحكم غنيمة لأبناء كل طائفة على حساب غيرهم، فضلا على تنازعهم على ثروات البلد، اذ كل يجر النار الى قرصه.
ولهذا السبب، أي الإصابة بتضخم النزعة الطائفية وتحكمها في نشوء وتطور الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر، إضافة الى اسباب أخرى غيرها، تجد ان هذا الخطاب لم يتوحد على أطروحة إسلامية جامعة، وأصبح زعماء الطوائف الدينيين لا المفكرين السياسيين ورجال الدولة الحركيين زعماؤه الروحيين، والوصاة على منحه الشرعية في الوجود والعمل السياسي، بل واعطوا أنفسهم الحق في تحديد من يُسمح له بالقيادة ومن يتم نزعها منه استنادا الى مبدأ الولاء لا مبدأ الكفاءة والاستحقاق القيادي.
ان النزعة الطائفية في الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر، في العراق وغيره من البلدان، سواء كان شيعيا ام سنيا ام سلفيا جعلت الحركات الإسلامية أكثر ضعفا في مواجهة خصومها، بل انها اضطرتها الى اللجوء الى العمل السياسي المسلح لفرض وجودها، لأنها لم تستطع التمدد بمشروع وطني-إسلامي شامل لجميع أبناء الوطن بصرف النظر عن مشاربهم الفكرية والمذهبية والدينية.
كما ان هذه النزعة جعلت الخطاب متخلفا عن عصره فهو خطاب يتناسب مع دول الطوائف في القرون الوسطى ولا يتناسب مع دولة المواطنة والقانون والمؤسسات في الوقت الحاضر، ولن يتطور الفكر السياسي الإسلامي المعاصر ابدا ما لم يعالج هذا العيب فيه، فهو اما ان يكون فكرا طائفيا يعمل في خدمة أبناء طائفته او يصبح فكرا سياسيا منفتحا على جميع المواطنين ويقودهم في دولة حديثة تلبي حاجاتهم وتستجيب لرغباتهم المشروعة في التطور والارتقاء الحضاري.
الانقسام السياسي آفة خطيرة استوطنت الخطاب السياسي المعاصر للإسلاميين، شأنهم شأن اخوانهم في بقية التيارات السياسية العربية والإسلامية، كالقوميين واليساريين وغيرهم، وتسببت في اضعاف قوته ومنعته من تحقيق أهدافه. والانقسام بقدر ما يشير الى قوة النزعة الفردية السائدة في الثقافة السياسية لشعوب المنطقة، ولاسيما الشعب العراقي، تلك النزعة الميالة الى التنازع والتفرق في المواقف والأفكار بين أصحاب الاتجاه الفكري والديني الواحد لأبسط الأسباب، ومهما كانت الظروف، فأن الانقسام السياسي للإسلاميين حتمته –أيضا-طبيعة خضوعه المستمر لوصاية الخط العقائدي، كما سبق ان أشرنا اليه.
لقد ولد الخطاب السياسي الإسلامي في كنف الخطاب العقائدي الفقهي، لشعور الاسلاميين غير المتفقهين أن رؤيتهم السياسية لواقعهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي قاصرة ولا تكتسب شرعية وجودها الا اذا توفر لها غطاء عقائدي لفقيه ذي شأن، وهذه الحالة تجدها بارزة بصورة جلية في الخطاب السياسي الشيعي المعاصر، والأسباب الكامنة وراء ذلك كثيرة جدا، لعل في مقدمتها تقف مسألة دينية الخطاب نفسه، وما تقتضيه من تصدي الفقهاء لبلورته وتعزيز اسانيده وتهذيبها وفقا لمقتضيات الشريعة، إضافة الى افتقار الكثير من القوى الإسلامية المعاصرة في بدايتها الى مفكرين سياسيين بارزين مثقفين بالثقافة الدينية المطلوبة من غير الفقهاء، مما جعلها من الناحية العملية تواجه فراغا فكريا سياسيا سمح لبعض الفقهاء بملئه بحكم الامر الواقع، فمارس الفقيه داخل الحركة الاسلامية دورين في الوقت نفسه: دور المجتهد الديني وما يتطلبه من احاطة بعلوم الدين التي تسمح له باستنباط الاحكام من مصادر الشريعة، ودور المفكر السياسي وما يقتضيه من احاطة بظروف السلطة والسياسة والبيئة المحلية والدولية للمجتمعات الإسلامية، لرسم مسار الحكم والعمل السياسي وفقا لمقتضيات الدين والعصر.
فضلا عن السببين السابقين، يوجد سبب آخر لا يمكن اهماله او تجاهله وهو أن معظم الحركات الإسلامية المعاصرة قد ارتبط ظهورها بوجود الشباب المتدين المندفع عاطفيا والراغب في إيجاد حلول ناجعة لما تعانيه المجتمعات المسلمة من تخلف واحباط وغياب للحرية والعدالة انطلاقا من الرؤية الدينية، وهذا الشباب بحكم عمره، وتجربته، ومستوى تفكيره، وطبيعة بيئته لم يكن مستعدا لتحمل عبأ وضع الاطروحة الدينية المناسبة لتحقيق أهدافه، ولذا القى ثقله –أيضا-وراء الفقهاء مطالبا إياهم بإيجاد هذه الاطروحة وتحمل مسؤولية الدفاع عنها فكريا وفقهيا.
ان بروز الخط العقائدي المتمثل بدور الفقهاء داخل التيارات الإسلامية المعاصرة ليس عيبا، طالما انها تيارات تنطلق من الدين لإصلاح الواقع، ولكن المشكلة توجد بوصاية الخط العقائدي على الخط السياسي اثناء العمل السياسي لهذه التيارات ومواجهتها خطر انتزاع الشرعية الدينية منها من قبل رموز هذا الخط، ومنبع المشكلة في هذه الحالة أمران:
الامر الأول- عدم وحدة الخط العقائدي، فكما هو معروف ان عمل هذا الخط يقوم على الاجتهاد، والاجتهادات تختلف باختلاف عقول البشر، واذا كان ممكن حصول الاتفاق بين الفقهاء في اساسيات العقيدة، فمن الصعب اتفاقهم في الأمور الأخرى المرتبطة بالحكم والسياسة والاجتماع، فهذه الأمور تعد ميدانا مفتوحا للاجتهاد البشري، وكل فقيه يدلي فيها بدلوه، ويستنبط الاحكام التي يراها مناسبة لها، ولذا تتعدد اطروحات الفقهاء، وفي بعض الأحيان تتقاطع في داخل النظرية السياسية الواحدة، كنظرية ولاية الفقيه، والشورى والديمقراطية، والمصلحة العامة، والثروة العامة، وغيرها. وتقاطع هذا الطروحات سيقود بالنتيجة الى تقاطع التيارات السياسية المنضوية تحت لوائها، وكلما اقتربت هذه التيارات من الأمساك بالسلطة زاد الافتراق والصراع فيما بينها، لأنها ستكون قريبة من الانتقال من النظرية الى التطبيق، فما يوحدها غالبا خطر الظروف والقوى التي تتصارع معها في بيئتها المحلية والدولية، ولكنها بمجرد تخلصها نسبيا من هذا الخطر تبرز لديها مشكلة اختلافات طروحاتها الفكرية وعدم انسجامها وتعايشها مع بعضها، ولذا تجدها تتصارع فيما بينها بشدة، واحيانا ينقسم الاتجاه السياسي الواحد الى اتجاهات عديدة يتبع كل منها فقيه لديه اجتهاد سياسي مختلف.
الامر الثاني-يرتبط بطبيعة الميدان السياسي فهو متغير متبدل يتطلب مساحة من حرية العمل لا تكون –أحيانا-متاحة للفقيه الذي تقيده الصلابة العقائدية، ولذا قيل ان السياسة هي فن الممكن وميدانها هو التجربة، والمغامرة، وتحمل المخاطر، والمساومة، والقبول بأنصاف الحلول عند الضرورة، والاعتراف بالخطأ، والتراجع عن بعض المواقف... ولذا تحتاج الى رجال دولة عمليين قادرين على خلق الاصطفاف السياسي العام مهما كانت صعوبة الظروف ووعورة الطريق، ومثل هذه الأمور صعبة –غالبا- على الفقيه الديني، ولذا تجده يتخذ موقفا يتصف كثيرا بالحذر السياسي، وعدم الاستعداد للتراجع عن اجتهادات ليست خاطئة من الناحية الدينية، كونها مبنية على علم الفقيه ومعرفته الطويلة بأصول عقيدته، لكنها ربما لا تكون مناسبة من الناحية السياسية.
ان الصلابة الفقهية ستنعكس حتما على الصلابة السياسية، فتتجمد مواقف القوى الإسلامية وتتمحور حول رموز الخط العقائدي، وتفقد هامش قدرتها على المساومة والمناورة وخلق الاصطفافات السياسية، فتفضي هذه الحالة الى انقسامات اشد خطورة داخل الخط السياسي.
وسيهون ما ذُكر أعلاه قليلا، إذا اقتصر الامر على فقهاء المذهب الواحد، داخل المجتمع الواحد، ولكنه سيكون مأساويا بصورة كارثية عندما يرتبط بفقهاء مذاهب دينية عديدة، لا تقتصر اختلافاتهم فيما بينهم حول الأمور الاستثنائية المستحدثة، بل تشمل-أيضا-بعض أساسيات العقيدة المتعلقة بشخص الحاكم (خليفة، امام)، وحدود سلطاته، وآليات الحكم، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، والقضاء، وغيرها من الأمور التي لم يحسم الجدل فيها بين المسلمين لقرون طويلة.
وبروز الاختلافات الفقهية في هذه الأمور وخروجها من ميدان العلم الى ميدان السياسة، سيعني خروجها من ميدان الخاصة الى ميدان العامة، ومن فضاء الجدل العلمي المحدود الى فضاء الصراع السياسي المحموم، مما يزيد من تعكير أجواء هذا الفضاء المتلبدة أصلا بالفوضى والارتباك وضيق الأفق، وغلبة المصالح الخاصة على المصالح العامة، وهذا للأسف ما حصل للخطاب السياسي الإسلامي بجميع تياراته، داخل العراق وخارجه، وقد شهدت بلدان المنطقة لأكثر من مرة تحول أصدقاء الامس المعارضين الى أعداء لدودين اليوم، بل وجرت محاولات لتصفية بعضهم للبعض الاخر، وممارسة مستويات مرتفعة من التعصب والتطرف السياسي الذي شوه صورة مشروعهم الإسلامي، وشكك المتابعين له بصدق وعوده، ومدى أمانة وإخلاص أصحابه، ففي النهاية الناس تتبع الناجح في بناء الدولة والمجتمع، والانقسام السياسي أصاب الإسلاميين في مقتل واظهرهم بمظهر الناجحين في التشتيت والهدم اكثر من التوحيد والبناء.
وإزاء ما تقدم من تأثيرات بالغة تركتها العوامل المؤثرة على الخطاب الإسلامي المعاصر في مرحلة التأسيس، فليس امام هذا الخطاب من سبيل للنجاة من الانحدار والزوال، الا البدء بسرعة بإعادة النظر في منطلقاته الفكرية والعملية، من اجل تجديدها وتقديم خطاب مختلف ينسجم مع حاجات العصر، وقادر على الاستجابة لتطلعات الشعوب المسلمة وغير المسلمة في العالم الإسلامي، وان السبل الى ذلك ستكون موضع المقال الثالث لهذه السلسلة.
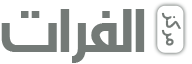










اضافةتعليق