لندن ـ إن السباق على زعامة حزب العمال البريطاني لا يشكل عادة حدثاً قد يهز العالم. ولكن السباق الذي جرى مؤخراً بين أخوين ـ ديفيد و إد ميليباند ـ لم يكن بمثابة مادة لدراما عائلية مثيرة فحسب؛ بل لقد صور أيضاً بعض الخصائص الغريبة التي تتسم بها الثقافات الديمقراطية والتي غالباً ما تمر دون أن يلحظها أحد ـ والعلاقة الغريبة بين الشخصي والسياسي في البنية الهرمية للبروتوكول الديمقراطي.
إن السياسة، أو على الأقل ممارسة السلطة، كانت تقليدياً شأناً أسريا. فكان الملوك يتحرقون شوقاً إلى إنجاب ورثة من الذكور، وذلك لأن السلطة كانت تكتسب أو تُخَوَّل للذُرية عبر النَسَب، وتوزع عبر الانتماءات القَبَلية.
ولم تكن السلطة الموروثة تشكل بالضرورة أساساً لعلاقات أسرية دافئة ومنفتحة. على سبيل المثال، كان هنري الثامن على استعداد لإعدام زوجتين ونقض الديانة المسيحية في سبيل إنجاب وريث ذكر. وهناك أمثلة في المجتمعات التي تبيح تعدد الزوجات لمحظيات ملكيات يقتلن أبناء بعضهن البعض من أجل ضمان الهيمنة لسلالاتهن. ولقد قدم العثمانيون ممارسة "قتل الأخوة الملكي الشرعي" لمنع الحروب الأهلية كما زعموا.
وسواء انطوت على ولاء مطلق أو خصومة قاتلة فإن السياسة التقليدية كانت نادراً ما تنفصل عن العاطفة الشخصية. ولكن الأمر اختلف في الأنظمة الديمقراطية الغربية الحديثة حيث من المفترض في العواطف الشخصية، من حيث النظرية على الأقل، أن تكون منفصلة تمام الانفصال عن التمثيل المتجرد النزيه لمصالح مجموع الناس.
بدأت الديمقراطية في أصولها الإغريقية بخلق مجال عام متميز عن الأسرة ـ والعواطف العميقة المرتبطة بها. ولكن الأنظمة الديمقراطية الحديثة ـ وبخاصة تلك التي تُدار وفقاً للنموذج الأنجلوسكسوني ـ تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، من خلال محاولة الفصل ليس فقط بين الخاص والعام، بل وأيضاً فصل الشخصي عن السياسي.
وهذا الانفصال ملحوظ بصورة أو أخرى في الأداء الظاهري للنظام الديمقراطي. فبعد أي مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة أو بريطانيا، يتصافح المتنافسان، اللذان ربما اتهم كل منهما الآخر أثناء المناظرة بارتكاب أشنع الخطايا التي لا تغتفر، ويودع كل منهما الآخر بابتسامات ودودة ومشجعة.
وأياً كانت درجة مقت أو كراهية باراك أوباما لوجهات نظر جورج دبليو بوش فقد كان ملزماً بالجلوس مع الرئيس السابق في اجتماع سري ـ وودي بكل تأكيد ـ لإطلاعه على أسرار الدولة. وفي المناقشات البرلمانية، قد تنشب معارك إيديولوجية شرسة، ولكن أي هجوم شخصي يُعَد خارج حدود المسموح.
وكل هذا يصب في المصلحة العامة بلا أدنى شك، ويشكل ضرورة قصوى لتنظيم الحياة الديمقراطية؛ ولكن بالنسبة لهؤلاء الذين لم يتعودوا على ذلك فإن القدرة على الجمع بين الخصومة والمودة قد تبدو منافية للمنطق. بل وربما يكون الانتقال من السياسة العاطفية إلى السياسة النزيهة المجردة من الهوى الشخصي واحداً من أصعب التحديات التي تواجه أنصار التحول الديمقراطي في كل مكان.
ففي أوروبا الشرقية ما قبل عام 1989، على سبيل المثال، كانت المواقف الإيديولوجية للساسة تُرى باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ذواتهم الأخلاقية البشرية. وكان المنتمون إلى الجانب الخطأ من الانقسام السياسي لا يُعَدّون في نظر الجانب الآخر مذنبين بتبني وجهات نظر خاطئة فحسب؛ بل كانوا يُعَدّون مخطئين في جوهرهم، وبالتالي يستحقون الإدانة والكراهية.
والواقع أن فكرة معاملة الخصوم السياسيين ببشاشة وود، وربما تناول مشروب أو ما إلى ذلك معهم بعد ساعات العمل ـ أو الدخول في حكومة ائتلافية معهم ـ قد لا تبدو غير طبيعية وحسب، بل وغير لائقة أيضا. والواقع أن تعليق المشاعر الشخصية في بعض الأنظمة الديمقراطية الشابة، أو الثقافات الأكثر تقلبا، لا يراعى بنجاح في كل الأحوال.
ففي العام الماضي، كان بوسع المرء أن يشهد ملاكمات بالأيدي في برلمانات من العراق إلى تايوان إلى تركيا، وكان أبرز هذه الملاكمات في أوكرانيا. وفي نظرنا فإن مثل هذا السلوك يبدو غير لائق وغير مرغوب أو متوقع، بل وحتى غير حضاري؛ أما بالنسبة للمشاركين فإن هذا السلوك ربما يمارس كفيض طبيعي من المشاعر القويمة.
من الواضح أن الشجارات البرلمانية ليست طريقة عمل مرغوبة. ولكن إلى أي مدى قد يذهب الفصل بين الشخصي والسياسي ـ وإلى أي درجة قد نصدق هذا الفصل؟
كان السباق بين الأخوين ميليباند بمثابة مثال صارخ لما قد نطلق عليه مكافحة المحسوبية ـ أو محاولة تجريد السياسة من كل الارتباطات الخاصة أو الشخصية. فبينما جلس الأخوان معاً، وتحدى كل منهما وجهات نظر الآخر، حاول كل منهما أن يحافظ على وهم مزدوج مفاده أنهما من ناحية لا يوجد بينهما ارتباط خاص، وأن خلافاتهما الشرسة من ناحية أخرى لم تؤثر على عواطفهما الأخوية.
ولبرهة من الوقت، كان الحوار بينهما يتسم بقدر كبير من التهذيب؛ ولكن التفكير المزدوج المعقد في هذا السياق انكشف عندما فاز الأخ الأصغر إد بهامش ضئيل، في انقلاب مباغت في آخر لحظة. وفجأة تحول الأمر برمته إلى أحداث غير لائقة. ففي وسائل الأعلام بدأت تظهر مقارنات بين الأحداث الأخيرة وبين سرقة عيسو لحق يعقوب بالميلاد، وبين العديد من الوقائع الشكسبيرية التراجيدية. والواقع أن القرار الذي اتخذه ديفيد ميليباند بالتراجع عن سياسات المواجهة أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمر اشتمل على عملية قتل رمزية ـ وإن المرء ليتساءل عما إذا كانت أعمال العنف السيكولوجي التي ارتكبها إد ميليباند قد تطارده في وقت لاحق، على غرار ما حدث في مسرحية ماكبث، فتعوق أداءه السياسي في المستقبل.
عندما نحكم على المرشحين لمناصب عليا، فإننا نجد ما يشجعنا على تجنب "سياسة السمات الشخصية" وتجاهل تلك الجوانب من هوية الساسة مثل حياتهم الروحانية، وسلوكياتهم الشخصية (ما لم يرتكبوا تجاوزات واضحة)، ومظهرهم، وذوقهم الجمالي، وحسهم الفني. وفي الممارسة الفعلية لا يتمكن إلا أقل القليل من البشر من تصنيف مفاهيمهم والفصل بينها بوضوح ـ وقد لا تكون هذه القدرة مرغوبة في كل الأحوال.
فرغم أننا قد لا نريد للساسة أن تحركهم مصالحهم الذاتية، فلابد وأن نعترف بأن أهل السياسة بشر لهم أنفس تتشكل وفقاً للعديد من العوامل ـ والعواطف. وبعبارة أخرى، لا ينبغي لنا أن ننظر إلى السياسة من زاوية ضيقة تجعلها أشبه بعملية آلية لمعالجة السياسات، بل يتعين علينا أن نتذكر ـ ولو في سبيل إصدار حكم أكثر اكتمالاً وواقعية ـ أن الساسة بشر مثلنا.
إيفا هوفمان مؤلفة رواية -فُقِد في الترجمة- ورواية -ما بَعد المعرفة-، ورئيسة تحرير صحيفة نيويورك تايمز سابقا.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2010.
www.project-syndicate.org
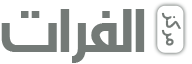
اضافةتعليق