زاخرة هي كتب التاريخ بسير الحكام والزعماء ، وقليل منهم العظماء ، واقل منهم من حمل رسالة الإصلاح والنهضة وبذل النفس والأهل من اجل غاية سامية ، ذلك أن القيادة رسالة حضارية لا يفك طلاسمها ويحمل أعباءها الجسيمة إلا من كان ذو حظٍ عظيم ، أو كما قال"بيرنز": (القيادة هي من أكثر الظواهر على الأرض وضوحًا، وأقلها إدراكًا) ومن قبله قال الحسين عليه السلام " يا ابن ادم تفكر وقل : أين ملوك الدنيا وأربابها ... فارقوها وهم كارهون ليرثها قوم آخرون ونحن بهم عما قليل لاحقون " ؛ فهي إذن مسؤولية ورسالة جسيمة قبل أن تكون موهبة ذاتية أو خبرة ومهارة صقلتها التجربة والممارسة ، مجالها القدرة على التأثير بالآخرين واستثمار طاقاتهم وصولا لتحقيق الأهداف وتحقيق الإرادة الإلهية في الخلافة وأعمار الأرض. وإذا كان التاريخ قد انحنى وجلاً ليسجل على سفره الخالد بأحرف من نور ذكر الحسين ( ع ) وثورته التي أشعلت بقبسات أنارت الأمل في نفوس المظلومين والمسحوقين بقرب فجر الخلاص من الطغاة المفسدين مهما استطال أمدهم واستطار شرهم ، فان ذلك ينبغي أن يقدح في ذهن الباحثين عن الحقيقة ، الجوهر البراق لرسالة إنسانية أخرى لا تقل أهمية ووهجا عن الرسالة الأولى سجلها الحسين عليه السلام في سفر التاريخ بسيرته العطرة في مجال القيادة ، إذ لا وجود لثورة من غير قائد ، وثورة بهذا الحجم والمقياس التاريخي الفذ لابد لها من قيادة شخصت فيها أسمى صفات القيادة في أبهى صورها . كيف لا وهي القيادة التي تجذرت أصولها واستمدت أحكامها ومنطلقاتها من منبع الفيض الإلهي المقدس والدوحة المحمدية المطهرة وتراه يخبرنا بهذه الحقيقة قائلا : ((نحن حزب الله الغالبون وعترة رسول الله الأقربون وأهل بيته الطيبون واحد الثقلين الذين جعلنا رسول الله ثاني كتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه تفصيل كل شي ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والمعول علينا في تفسيره ولا يبطئنا تأويله بل نتبع حقائقه)) ، فاستلهم الإمام عليه السلام مقاصد الرسالة النورانية للقران لإرساء دعائم الأساس المقدس لقيادته على قاعدة رصينة من الحق المنبثق من الإيمان المطلق بوجوب النهوض بمتطلبات الدور الرسالي الذي شرع به المصطفى (ص ) ليتحدد في ملكوت ذلك ، المدى الذي انطلقت منه وسارت عليه رسالته السامية في ترسيخ دعائم الحكم الإلهي الشرعي في مواجهة الانتكاسة التي مني بها المجتمع المسلم في ظل الحكم الأموي . ومن ينبوع ذلك الفيض الإلهي المقدس يرتسم مجال الهدف السامي لتلك المنطلقات الحسينية المطهرة في الإصلاح كما تجلى ذلك في الوصية التي خطها الحسين عليه السلام لأخيه محمد بن الحنفيّة(رض) التي جاء فيها: (وإنّي لم أخرج أشراً (الأشر: من الشر)، ولا بطراً ولا مُفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح، في أمّة جدّي محمّد(ص)، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي محمّد(ص)، وأبي علي بن أبي طالب(ع)، فمن قبلني بقبول الحقّ، فالله أولى بالحقّ، ومن ردّ عليّ هذا، أصبر حتى يقضي الله، بيني وبيّن القوّم بالحقّ، وهو خيّر الحاكمين). فمن غير الهدف يضيع الجهد وتتبدد الطاقات ، ويتلاشى الأمل وتعم الفوضى . وبالمثل لا يكون الهدف إلا مشروعا وساميا ضمن منطلقات العصر ومحدداته ليتكرس بالعمق المنشود في قلوب الأنصار والأتباع ، وتشحذ به العزائم على الإقدام وصولا لتحقيق المرام . وتبعاً لذلك لا يمكن الحكم على شرعية الهدف وجدواه بعيدا عن المنهج والوسيلة التي يعتمدها القائد . وعن منهجه في الحكم والقيادة قال الحسين عليه السلام مجيبا احد أصحابه لما سأله عن ذلك " نحكم بحكم ال داود فإذا عيينا عن شيء تلقانا به روح القدس" . وأما الوسيلة من هذا المنطلق والأساس ينبغي لها أن تستمد شرعيتها من شرعية الهدف والمنهج ، إذن لا عزاء لمن قال " إن الغاية تبرر الوسيلة " ولا وزن لهذا المنطلق في رؤية الحسين عليه السلام لهذه الوسيلة ومصداق ذلك قوله " من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجئ ما يحذر" وتأكيده عليه السلام في مناسبة أخرى لهذا المنطلق بالقول" لا افلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق " . ومع إمعان النظر في المدرك الحسيني لنهج القيادة يتراصف في المدى المنظور نسق تراتبي من صفات تلك القيادة ، يقع على مستويين مترابطين ؛ يتعلق النسق الأول ببنية تلك القيادة وشروطها ، وينعقد النسق الثاني بلواء العلاقة مع الرعية والأتباع . ما يتقدم المستوى الأول لبناء نهج القيادة الحسيني من شرائط ومستلزمات القيادة ، يتجلى بطهارة الأصل والنشأة للقائد ، ودرة تاج هذا المطلب (النسب الهاشمي المحمدي) إذ آمن الإمام الحسين (ع) أن العترة الطاهرة أولى بمقام رسول الله (ص) وأحق بمركزه من غيرهم، لأنهم أهل بيت النبوة ، ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بهم فتح الله، وبهم ختم - على حد تعبيره - وليس أدل على ذلك من قوله ( عليه السلام )(أيّها النَّاس ، إنَّكم إن تَتَّقوا الله وتعرفوا الحقَّ لأهله يَكن أرضى لله ، ونحن أهلُ بَيت محمد أوْلَى بولاية هذا الأمر من هَؤلاءِ المدّعين ما ليس لهم ، والسائرين بالجور والعدوان) لاسيما وانه قد نشأ في كنف الكرام المطهرين محمد وعلي عليهم الصلاة والتسليم. فان انقطع هذا الشرط أو استعصى تحرينا فيه الأصل العام والأساس الرشيد في إرساء أولى دعائم القيادة على وفق مقاييس الحسين عليه السلام . وينساب من عطاف ما تقدم ويمزج به أصلان أو ركنان آخران لا تقل أهميتهما عن الشرط الأول ، هما العلم الواسع المشفوع بالعمل والإيمان الراسخ بالمبادئ والمعتقدات والانقياد التام لها والتطبع بالسلوكيات المنبثقة عنها بإحراز المعنى الحقيقي للإيمان وليس الاكتفاء بالعقيدة المحنطة بالقلب لقوله عليه السلام " فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب، والآخذ بالقسط، والدائن بالحق، والحابس نفسه على ذات الله " . وقبل مغادرة محطة الشروط التأهيلية لشخصية القائد الحسيني الفذ ، يبقى الشرط الذي يشكل المعبر المفترض ما بين النظرية والتطبيق، وبين البناء الذاتي والقدرة على التأثير العميق في الجماعة الإنسانية والمستوي على قاعدة الخبرة الميدانية لذلك القائد أسوة بالحسين ( ع) الذي خبر أحنك الظروف وعصفت على زمانه كل الخطوب التي عصفت بالدولة الإسلامية أبان مراحلها الانتقالية الحرجة حتى اشتد أزره وتشرب خبراته من معين القيادة الرسالية لجده المصطفى وكان لأبيه وأخيه عند الحكم خير سند ، فمن مثل هذا المعين تسقى شجرة القيادة الرشيدة ، وتصقل مواهب القائد حتى يحمل عبئ توجيه دفة الإصلاح والنهضة لامته . وإذا كانت تلك أهم منعرجات الاختيار الحسيني للمؤهلات الذاتية للقائد الفذ؛ وهي لعمري غيض من فيض علمه الرباني الذي لا تطاله العقول ولا تستجمع حكمه الأقلام . فان التعمق بالخطاب الحسيني يفضي بنا إلى استكشاف طيف آخر من الصفات والمعايير التي تقع على مستوى علاقة القائد الحسيني برعيته وأتباعه يتقدمها شرط العدل والإنصاف ، فلو لم يكن الحاكم عادلا ملتزما بالدين عاملا بالحق لزم نقض الغرض من المحالات العقلية على الشارع الحكيم ومن القبائح العقلانية على غيره . وقد أوجز الإمام هذا الغرض حين أوصى ابنه علي بن الحسين ( عليهما السلام ) بالقول : (( أي بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله جل وعز )). مطلقا عنان هذا المبدأ – كأصل عام- في سماء الإنسانية دون النظر إلى المسميات والمناصب ، مرجحا أولويته وخصوصيته مع تحقق صفة الاقتدار الذي قد يدفع النفس الأمارة إلى ضفاف الغرور والظلم والعدوان ؛ بل ترى الحسين يذهب في تكريس هذا المبدأ في أعماق الذات الإنسانية إلى أقصى حدٍ بتفضيل الموت على الحياة مع الظالمين قائلا (إِنِّي لا أرَى المَوتَ إلا سَعادةً ، وَالحَياةَ مَع الظالمين إِلاَّ بَرَماً). ويجتمع ذلك الركن المستلزم من القائد الفذ، مع نظيره القادم من ارض الرباط وسوح الوغى المتجسد بالشجاعة والإقدام ، على قاعدة الضرورة العملية المقدمة في سياسة الرعية حتى يكون القائد بها على حجم المسؤولية التاريخية ومستلزماتها مقداما إذا اشتدت المحن وألمت به المصائب ، غير متخاذل ولا متردد لأنه بذلك تفتح بوابات الشر على الرعية وتعصف بأمنهم أعاصير الأطماع والتقلبات وهذا ما عبر عنه الحسين بالقول " : (( شـر الملوك .. الجبن عن الأعـداء )) وباستنطاق مفهوم المخالفة تتأكد سمة الشجاعة التي رامها الإمام في الحاكم الشرعي . وكرسها اعتقادا ومنهجا ومواقف ؛ حسبه منها انه قدّم نفسه وإخوته، وأهل بيته وأصحابه، مِنْ أجل قضيته في الإصلاح والتغيير دون خوف أو تردد . فتراه عليه السلام يقف بوجه الحاكم الطاغية ليقول كلمة الحق لما أراد منه بيعة يزيد قائلا " (هذا هو الإفك والزّور، يزيد شارب الخمر ومشتري اللهو خير مني؟.). وأكدها بوجه حاكم المدينة وواليها قائلاً ( مثلي لا يبايع مثله ) ؛ بل انه حقق سبقا من ضروب الشجاعة لا يقربه إنسان لما أقدم على ثورته وهو عالم بمصيره يوم قال لام سلمه يا أماه " إني مقتول لا محالة وليس لي من هذا بد ... ثم قال يا أماه قد شاء الله عز وجل أن يراني مقتولا مذبوحا ظلما وعدوانا " ليتجلى في هذا الموقف كل أبعاد الشجاعة وأعظمها . غير أن الشجاعة التي حملها الحسين في قلبه المفعم بالإيمان قد زادته رحمةً وترفقا بأتباعه وأنصاره ليعلم قادة العالم ضرورة التواصل مع الرعية واكتساب محبتها قبل خوفها حتى يكونوا درع الدولة وسيفها وسند القائد وحصنه في الملمات والصعاب يخوض بهم غمار البحور فلا يتفرق جمعهم ولا تنكسر عزائمهم ، حتى وجدنا أنصار الحسين عليه السلام يتسابقون على فداءه بأرواحهم مقتدين بشجاعته مؤمنين بعدالة قضيته تواقين لحتفهم تحت راية الحق.
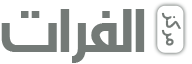








اضافةتعليق