انه " ضربة موجهة الى أوروبا" بهذه الكلمات وصفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل نتيجة الاستفتاء البريطاني الذي جرى يوم الخميس الماضي (23حزيران –يونيو) وصوت فيه اغلبية الناخبين البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، اما نائبها زيجمار جابريل فقال: " اللعنة، يوم سيء بالنسبة لأوروبا". نعم ان أوروبا الموحدة التي تندمج ثقافاتها المتنوعة، ويتكامل اقتصادها، وتتوحد مؤسساتها الدستورية والأمنية فشلت في جذب البريطانيين للبقاء فيها، وهذه النتيجة تتطلب التأمل في دلالاتها العميقة؛ لأنها قد تكون حقا زلزال بريطانيا الذي سينتج عنه تسونامي غير محدود النتائج. الإرهاب والتطرف ينتصران في أوروبا بالنسبة الى فراك فولتر شاينماير وزير خارجية المانية كان يوم الاستفتاء يوما " حزين بالنسبة لبريطانيا ولأوروبا"، ولكنه كان يوما سعيدا جدا لقوى الإرهاب والتطرف، سواء تلك المسؤولة عن هجمات بروكسل وباريس، والمسؤولة عن تدمير العراق وسوريا واليمن وليبيا ومصر وغيرها من الدول تحت مسميات الإرهاب الجهادي أو الحكومي الذي خلف أكبر أزمة لاجئين في تاريخ العالم، او تلك التي تطل برأسها في القارة العجوز باسم العنصرية والشوفينية القومية. ان هدف جميع قوى التطرف والارهاب هو اثارة مشاعر الكراهية اتجاه الاخر، واستبعاده، والقضاء عليه ان لزم الامر، على خلاف فكرة الاتحاد الاوربي القائمة على احترام التنوع والاندماج الثقافي، وقبول الآخر، وتجاوز الأحقاد الدفينة، لذا لا غرابة ان نرى مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية تعلق على نتيجة الاستفتاء بالقول: انه " انتصار للحرية .. الان نحتاج لاستفتاء مماثل في فرنسا، وفي دول الاتحاد الأوربي"، ويتناغم معها في الرأي خيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية الهولندي بالقول: " مرحى للبريطانيين الان حان دورنا حان الوقت لاستفتاء هولندي"، وماتيو سالفيني زعيم رابطة الشمال الإيطالية بالقول: هذا رائع، انه فوز للمواطنين الاحرار انها هزيمة للكذب وللتهديدات والتشويه". ولو قدر لزعماء القاعدة وداعش والأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط ان يعلقوا بصدق على هذا الموضوع لكانت كلماتهم لا تشذ عن كلمات زملائهم الأوروبيين. صفوة القول، ان الإرهاب والتطرف ينتصران في أوروبا، هذه الحقيقة لا يجوز التغافل عنها وانكارها، فمشاعر الكراهية اتجاه الاخر تتصاعد يوما بعد آخر في هذه القارة، وما لم يتم تدارك الأمور بسرعة، فان كل شياطين صندوق باندورا ستخرج من جديد، فتعيد الصراعات المدمرة الى أوروبا والعالم. اصلاح الاتحاد الأوربي مسألة لم تعد تقبل التأجيل على الرغم من ان السيدة ميركل ترى أن: " وحدة الاتحاد تحمي قيمنا السياسية والاجتماعية"، الا أن عليها وعلى زملائها الـ27 المتبقين في الاتحاد الإقرار بان هناك أخطاء يعاني منها اتحادهم في بنيته المؤسساتية التي افتقرت الى الديمقراطية -قيام المفوضية الاوربية غير المنتخبة بوضع مشاريع القوانين للبرلمان الأوربي المنتخب من الشعوب مثل صارخ على ذلك- وفي سياساته الاقتصادية التي لم تعالج مشاكل أساسية لمواطنيه كمشكلة البطالة وأسعار الفائدة وأزمة اليورو، فضلا على عجزها عن تلافي مشكلة التفاوت في الأداء الاقتصادي بين أعضائه، مما جعل دوله الثرية تتعرض الى تدفق بشري هائل من دوله الفقيرة للعمل او الإقامة فيها، فالإحصاءات تتحدث عن توافد اكثر من مليون وافد سنويا للإقامة في بريطانيا، فضلا على الرسوم العالية التي تدفعها الدول الى الاتحاد- بريطانيا تدفع 55 مليون جنيه إسترليني يوميا- والتوسع المفرط في عضويته بعد نهاية الحرب الباردة بدون مراعاة ظروف وحاجات دوله المؤسسة الأساسية. لقد أصبح البقاء في الاتحاد عبئا ثقيلا على بعض الدول ومواطنيها، الذين يضعون التجربة السويسرية نصب اعينهم، فسويسرا غير المنتمية الى الاتحاد اغنى في دخلها الفردي والاجمالي وأفضل حالا من بريطانيا العظمى. كل هذه التحديات تتطلب إعادة نظر جدية في بنية الاتحاد المؤسساتية وسياساته العامة الأساسية. لقد امتلك السيد روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا الشجاعة ليقول:" انه من واجبنا نحن 27 دولة الباقية في الاتحاد ان تكون لدينا القوة لنقول ان السياسات التي ينتهجها الاتحاد الأوربي الرئيسية يجب ان تخضع لتغييرات جذرية"، كذلك امتلكها السيد جيرار آرو السفير الفرنسي في واشنطن عندما قال: "على الأعضاء الآخرين حماية الاتحاد الأوربي من التفكك.. الإصلاح أو الموت". فهل يمتلك قادة اوربا الاخرين الشجاعة نفسها لقول ذلك واتخاذ الخطوات الأولى للتغيير؟ الغرب يدفع الثمن ان المشاكل الرئيسة التي يعانيها العالم اليوم، كمشكلة اللاجئين المتفاقمة، والهجرة غير الشرعية، وتوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء عموديا وافقيا على كوكب الأرض، وتصاعد العنف والإرهاب الذي تخوض اطرافه صراعاتها بأسلحة مدمرة انتجتها شركات السلاح الغربية، وغياب العدالة في المؤسسات الدولية الرئيسة كالأمم المتحدة، وسطوة المؤسسات الاقتصادية الغربية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والدعم الذي تتلقاه بعض الأنظمة المستبدة لمدها بطاقة البقاء والفتك اللا أنساني، وتنامي مشاعر الكراهية بين الأديان .. وغيرها من المشاكل التي تصاعدت حدتها مع تطور العولمة وتنامي ادواتها، يتحمل المسؤولية الأولى فيها الغرب بسياساته المزدوجة الخاطئة ابتداء من سياساته الاستعمارية التي انتهت بغرس إسرائيل في قلب الشرق الأوسط الإسلامي، مرورا بحروبه المدمرة في القرن العشرين، وما تمخض عنها من مؤسسات سياسية واقتصادية دولية تمثل مصالح المنتصرين لضمان السيادة والهيمنة على العالم، وصولا الى صراعات قواه الرئيسة في الوقت الحاضر التي تتخذ مناطق العالم حلبات مصارعة تستعرض فيها قوتها وقدرتها على التدمير والفتك بالآخرين، والقائمة بأخطاء السياسات الغربية طويلة للغاية. ان كل الأخطاء التي ارتكبها ولا زال يرتكبها الغرب ترتد عليه اليوم، وسيدفع ثمنها باهضا، فتنامي اليمين المتطرف، واحياء السياسات الانعزالية اتجاه الاخر، والاحتجاجات الداخلية المتصاعدة، واستفحال هاجس الشعور بعدم الأمان، والخوف من المستقبل ما هي الا مقدمات لمستقبل مجهول، واجراس انذار لأخطار قادمة تستدعي تغيير الغرب لسياساته؛ لجعلها اكثر توافقا مع متطلبات العدالة والإنسانية، ولكن لا أتوقع ان تعي حكومات الغرب هذا الامر وستستمر في سياساتها الخاطئة التي توصلها الى الكارثة يوما ما. لا تستفزوا الهويات الثقافية ولا تغفلوا عن اهمية المصالح الاقتصادية ان الدرس المهم الذي يجب ان يستوعبه الجميع من الحدث البريطاني هو ان تعرض الهويات الثقافية والمصالح الاقتصادية الى الخطر يحفز المجتمعات للتمرد على حكوماتها، فالبريطانيون الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي احتجوا بحجة ان خصوصيتهم الثقافية تتعرض الى الخطر بفعل ظاهرتي الهجرة واللاجئين، وان مصالحهم الاقتصادية تتعرض للخطر أيضا بفعل سياسات الاتحاد وقيود الانضمام اليه، لذا هم يرغبون باستعادة بلدهم حتى لو خالفوا إرادة حكومتهم. بالمقابل نجد ان نتيجة الاستفتاء دفعت السلطات في اسكتلندا وويلز ولندن العاصمة الى الحديث عن رغبتها في الانفصال عن المملكة المتحدة والبقاء في اوروبا؛ بسبب تضررها مصالحها الاقتصادية في حال الخروج، متمردة ايضا على رغبة حكومتها، ومعرضة وحدة بلدها الى الخطر. هذا الحراك الاجتماعي يتنامى على مستوى القارة العجوز، ومحركه الأساس الخصوصية الثقافية والمصالح الاقتصادية، وستكون له تأثيرات كثيرة في المستقبل. هذا الدرس البريطاني البليغ، يتطلب من الدول ذات الأنظمة السلطوية في العالم -لاسيما في منطقة الشرق الأوسط-ان تدرك ان العالم يتغير بسرعة، فلم تعد الحكومات هي الفاعل الرئيس في تحديد حدود السيادة والمصلحة، بل ان الاقتناع والرضى من جميع الشركاء في الوطن هو الذي سيحدد ذلك. وان القمع للخصوصيات الثقافية والاستهانة بالمصالح الاقتصادية سيخلق التمرد المحتم عاجلا ام اجلا، وعندها لن يطول الامر حتى نشهد تفكك دول قائمة، وبزوغ دول أخرى كثيرة على انقاضها.
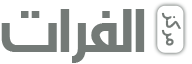






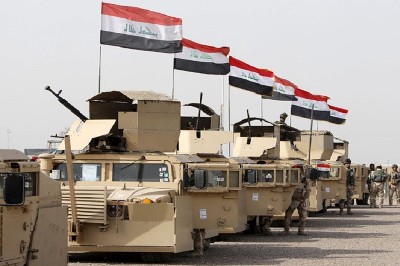
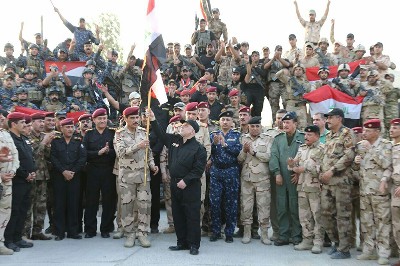




اضافةتعليق