لماذا لا تزال الديمقراطيات العريقة في أمريكا وأوروبا وغيرها قادرة على الاستمرار بلعب دورها الديمقراطي بفاعلية مقبولة، نوع ما في الوقت الحاضر، على الرغم من وجود الفجوة الكبيرة بين مواطنيها فوق العادة، ومواطنيها المثيرين للشفقة، فيما قد تعجز بعض الديمقراطيات الناشئة (حديثة العهد بالديمقراطية) عن لعب الدور نفسه، مما يعرضها الى الانتكاس السريع والفشل المريع؟
قامت الديمقراطيات الحديثة على قاعدة التوزيع العادل للثروة والسلطة بين المواطنين قدر الإمكان، وهذه القاعدة توفر إحساسا عاما بالمساواة بينهم، تعززه رابطة المواطنة السائدة بالانتماء الى دولة مدنية تترسخ في ثقافتها السياسية قواعد الديمقراطية وقيمها عن قناعة ورغبة صادقة للعمل وفقا لها؛ كونها الخيار الأمثل لإدارة الحكم وتوزيع مهام السلطة وصلاحياتها، مما يسمح بانفتاح الفضاء السياسي والاجتماعي لاستيعاب الاختلافات بين المواطنين سواء كانت لأسباب اثنية ام فكرية ام دينية ومذهبية. ولا نزعم في هذا المقال ان الديمقراطيات الحديثة قد حققت العدالة التامة بين مواطنيها في توزيع الثروة والسلطة، فالدلائل كلها تشير الى وجود فجوة كبيرة متسعة بين من يملكون ومن لا يملكون، حتى بات اغنى 1% من الافراد الاثرياء في بلد ديمقراطي كالولايات المتحدة يمتلكون من الثروة أكثر مما يمتلكه 90% من بقية الشعب الأمريكي. ان وجود هذه الفجوة يعني وجود خلل داخل هذه الديمقراطيات يضعف مبدأ المساواة بين المواطن وأخيه من جانب، ويغير اتجاه بوصلة المصالح والامتيازات باتجاه الأقوى والأكثر حظوة من جانب آخر.
ان هذه الصفوة من الافراد الاقوياء والاوفر حظا، هم من نسميهم بالمواطنين فوق العادة او المواطنين درجة أولى، أما البقية، فيمكن تسميتهم بالمواطنين المثيرين للشفقة، الذين يتناسب ترتيب درجة مواطنتهم بمقدار ضعفهم وموقعهم في سلم الهرم الاجتماعي، أي كلما زاد ضعفهم تراجعت درجتهم حتى تصل الى أدنى مستوياتها في قاع السلم، وقد تجد هناك مواطنين لا يمتلكون من حقوق المواطنة الا بطاقة الانتساب الى الدولة، وربما لا تجد هذه البطاقة في بعض الأحيان.
وفي ظل هذا الانقسام الاقتصادي والاجتماعي بين قلة متحكمة من المواطنين فوق العادة، وكثرة مغلوب على أمرها من المواطنين المثيرين للشفقة، يضطرب ميزان العدالة بين الطرفين متناغما مع اختلافهما في قوة الدور والتأثير، فتجد معظم السياسات والقوانين يجري اعدادها وصياغتها لمصلحة المواطن فوق العادة على حساب المواطن المثير للشفقة، فالأول مدلل النظام ومحركه، وكل شيء يعمل من اجل راحته ورفاهه، وتلبية حاجاته ورغباته، حتى غير المشروعة، أما الثاني فهو خادم النظام وتابعه، ومحل سطوته وعقابه، ومطلوب منه الخضوع له، حتى ولو على حساب حاجاته المشروعة، وطالما يخدم النظام المواطن فوق العادة، ويخدم المواطن المثير للشفقة النظام، تكون النتيجة ان النظام والمواطن المثير للشفقة يعملان في خدمة المواطن فوق العادة.
هذا الواقع الغريب البعيد عن الحلم الديمقراطي ينذر بفشل الديمقراطية واتخاذها مسارا غير مسارها الصحيح المحدد في غاياتها النبيلة. اذ كما يعتقد – وهو صائب في اعتقاده-الكاتب الأمريكي روبرت دال: فأن أي نظام حكم كي يصبح ديمقراطيا يحتاج الى " تلبية متطلبات الديمقراطية، ومنح الحقوق الكامنة فيها لكل المواطنين. أما الوعد بمنح هذه الحقوق الديمقراطية كتابة، وفي القوانين، أو حتى في وثائق دستورية فليس كافيا. يجب تطبيق هذه الحقوق بفاعلية، وان تكون متاحة فعليا لجميع المواطنين في الممارسة السياسية" (دال، عن الديمقراطية، ص 65). وعليه فان غياب المساواة بين المواطن فوق العادة والمواطن المثير للشفقة، يعني وفقا لدال نفسه: " أنك إذا حُرمت من صوت متساو في حكم الدولة، فان الفرص سوف تكون عالية جدا بأن لا تعطى مصالحك الاهتمام ذاته، الذي تلقاه مصالح الذين يمتلكون صوتا بالفعل" (دال، عن الديمقراطية، ص98).
وهذا ما يحصل في جميع دول العالم في الوقت الحاضر، لكنني استثني الدول الشمولية المستبدة من الحديث، لأنها ابتداء منكرة لحقوق وحريات مواطنيها، فلا معنى لقيمة المساواة في ظل نظام حكم يعتقد حكامه انهم فوق الدولة والقانون لأسباب دينية او سياسية او ناجمة عن الوراثة، لذا سنركز الحديث على الدول الديمقراطية، التي نجد انها تسير بشكل متسارع نحو إيجاد طبقة قليلة العدد من المواطنين فوق العادة (مواطن سوبر) الى جانب اغلبية واسعة من المواطنين المثيرين للشفقة ممن لا حول لهم ولا قوة، وكلما تقلص عدد افراد الطبقة الأولى وازداد تركيز الثروة والسلطة لديهم، واتسع عدد افراد الأغلبية المغلوبة على أمرها، كلما اكتشفنا انحدارا اكثر في منحنى الديمقراطية لتأخذ بالابتعاد عن مقاصدها وأهدافها. ولكن لماذا لا تزال الديمقراطيات العريقة في أمريكا وأوروبا وغيرها قادرة على الاستمرار بلعب دورها الديمقراطي بفاعلية مقبولة، نوع ما في الوقت الحاضر، على الرغم من وجود الفجوة الكبيرة بين مواطنيها فوق العادة، ومواطنيها المثيرين للشفقة، فيما قد تعجز بعض الديمقراطيات الناشئة (حديثة العهد بالديمقراطية) عن لعب الدور نفسه، مما يعرضها الى الانتكاس السريع والفشل المريع؟
الجواب هو ان الديمقراطيات العريقة لا زال لديها مصدات مناسبة تحميها من الانجراف بعيدا عن خيارها الديمقراطي، وأول هذه المصدات هو وجود مؤسساتها الدستورية الديمقراطية الراسخة، والتي من الصعب التلاعب بها او تهديد استقلاليتها بشكل كامل، فهذه المؤسسات كالمجالس التشريعية الاتحادية والمحلية أو المجالس العليا والدنيا، والمحاكم ، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية وغيرها، ما زال لديها القدرة على لعب دورها لمصلحة الغالبية من افراد المجتمع، بل ويمكنها في الساعات الحرجة تقدير حاجة المصالح العامة لتتجنب كل ما من شأنه تحديها أو ينذر بتشكيل تهديد جدي لها، لذا هي بحكم قوة تأثيرها تعي تماما ان تنازلها او تغييب دورها الدستوري بالكامل يعني أمرا في غاية الخطورة، مما يساعد على ظهور دورها الحاسم في جميع الظروف، فيكون من الصعب افسادها كليا او التلاعب بها.
إضافة الى دور المؤسسات الدستورية تجد ان قيم الديمقراطية وسلوكياتها تغلغلت في الثقافة السياسية للنخب الحاكمة والمحكومة، فحتى طبقة المواطنين فوق العادة لا يريد افرادها تحقيق مكاسبهم وضمان مصالحهم بعيدا عن هذه القيم والسلوكيات، فالجميع لديه قناعة بأنه رابح ويحقق مكاسبه بشكل أفضل في ظل الحكم الديمقراطي، وعليه هم يحترمون القوانين والأنظمة والقيم الديمقراطية في مؤسساتهم وعلاقاتهم، ولكن متى ما اهتزت هذه القناعة ستواجه هذه الديمقراطيات مصيرها المشؤوم، وتكون قد خطت خطواتها الأولى باتجاه التخلي عن حلمها السعيد، وربما يشكل بروز التيارات اليمينية والشعبوية المنتشرة في بعضها في الوقت الحاضر الشرارة القادمة لانتكاسها واستعادة مجتمعاتها لبدائيتها وسقوطها المريع يوما ما، هذا في حال لم يتم معالجتها والتعامل معها بالشكل والوقت المناسبين.
اما الديمقراطيات الناشئة، كالعراق وغيره من البلدان المماثلة، فالمؤسف حقا أنها خرجت من نير حكامها المستبدين السابقين لتقع تحت رحمة طبقة محدودة جدا من مواطنيها فوق العادة (السوبر)، يقابلهم غالبية من المواطنين المثيرين للشفقة، وقد مارست الطبقة الأولى شكلا مقيتا من أشكال الوصاية على الدولة ومواطنيها، ولكون المؤسسات الدستورية الديمقراطية، في هذه البلدان، لا زالت هشة وغير راسخة، ولم تكتسب احترامها المطلوب سهُل التلاعب بها لمصلحة الاوصياء الجدد، بكل الصور والأساليب المشروعة وغير المشروعة.
لقد تظافر، في هذه البلدان، غياب المؤسسات الدستورية الكفوءة مع أمر آخر أشد فتكا الا وهو غياب الثقافة الديمقراطية لدى غالبية النخب الحاكمة والمحكومة، وهذا الامر ليس غريبا على دول عاشت وقتا طويلا من عمرها تحت نير الاستبداد، فالقواعد والقيم وانماط السلوك الديمقراطي لم تكتسب بعد القناعة التامة بها من قبل الافراد، ولم يتم تدريبهم وتعويدهم عليها، وانما يجدها معظمهم شاذة عن أنماط سلوكهم المحكومة بعادات وتقاليد الاستبداد والعبودية، وبعيدة عن مؤسساتهم المجبولة على المركزية الشديدة وغياب الرأي الاخر، ابتداء من الاسرة وصولا الى قمة السلطة. وفي ظل هذه الثقافة ستجد أن الأكثر ضعفا من الافراد هم الأكثر ضياعا لأصواتهم، وتلاعبا بمشاعرهم، واهمالا لحقوقهم لمصلحة (إخوانهم) من المواطنين فوق العادة، وتزداد درجة مظلوميتهم واثارتهم للشفقة مع ارتفاع نسبة ضعفهم وتدني منزلتهم في المجتمع، كما هو الحال مع المرأة، والطفل، والفقراء من سكان المناطق غير النظامية (العشوائية)، والمنبوذين اجتماعيا (كالغجر وامثالهم).
ان ضعف المؤسسات الدستورية وغياب دورها المؤثر، وسيادة الثقافة غير الديمقراطية ضخم تأثير طبقة المواطنين فوق العادة (الاوصياء) في هكذا مجتمعات، وزاد الفساد المستشري، والافلات من سلطة القانون، وفوضى الحكم والسلاح من خطرهم، فأعطاهم هيمنة شبه مطلقة لاحتكار إدارة مؤسسات السلطة كتشريع القوانين وتفسيرها وانفاذها بما يتناسب مع ميولهم ومصالحهم، ناهيك عن تقاسم مغانمها وامتيازاتها فيما بينهم، لذا تجد احيانا آلافا عديدة من المواطنين المثيرين للشفقة يخرجون الى الساحات العامة وهم يتظاهرون ويحتجون على سوء أوضاعهم المعيشية، ولكنهم يتعرضون الى التنكيل الشديد والحرمان من حقوقهم المدنية بشكل او آخر، ناهيك عن عدم سماع شكواهم وتلبية مطالبهم المشروعة، فضلا على ملايين أخرى تشارك في انتخابات عامة آملة منها تغيير حالها الى ما هو أفضل، فتكتشف انها انما أضفت المزيد من المشروعية الى وجود طبقة الاوصياء الذين لا يتورعون عن اتخاذ أي موقف غير قانوني وغير أخلاقي عند الحاجة لتحقيق مصالحهم وفرض رؤيتهم السياسية.
ومع زيادة تركيز السلطة والثروة بيد قلة من المواطنين فوق العادة، واستمرار الحال على ما هو عليه (من حيث ضعف المؤسسات الدستورية وهيمنة الثقافة السائدة غير المؤاتية)، واتساع اعداد المواطنين المثيرين للشفقة، ستتنامى أحاسيس الشعور بالظلم وعدم المساواة، ويزداد العداء والكراهية بين الطرفين، مدعوما بغياب الثقة وتحكم الشك والريبة في العلاقة بينهم، فيبدأ كل طرف بالتخندق أزاء الطرف الآخر، فيغدوا انتهاك القانون، وفرض الاكراه، واحتكار الثروة والسلطة، وشراء الضمائر والذمم أدوات مشروعة بيد الاوصياء للحفاظ على مكاسبهم واستمرار هيمنتهم، فيما يغدوا عدم احترام القانون، وكره مؤسسات السلطة، والسطو على المال العام، واللجوء الى الخيارات غير الديمقراطية في تنظيم المؤسسات والعلاقات، والتطرف الفكري والسلوكي تحت عناوين مختلفة أدوات مشروعة بيد المواطنين المثيرين للشفقة، للتعبير عن تمردهم الدفين على الأوضاع العامة، وخيبة أملهم بديمقراطيتهم الناشئة. وفي ظل هكذا أوضاع شاذة وغير طبيعية في بناء نظام الحكم، ستستولي ستهتز بشكل كارثي منظومة القيم الاجتماعية، وتسود عقلية الصراع والغلبة على العلاقات العمودية والافقية في المجتمع، وتغيب رقة الطباع ومدنيتها أمام سيل جارف من أحاسيس الحنق والفظاظة، والشعور بالظلم وانعدام العدالة، والقسوة في إطلاق الاحكام وارتكاب الافعال، فيكون الخاسر الأكبر الموضوعية وخياراتها العقلية، ففي ظل واقع غير منطقي تصبح المعالجات المنطقية غير منطقية لدى الكثير من الناس، وهذا.
ان المواطن الفعال والمبادر هو الجوهر المحرك للمسار الديمقراطي، والسر الكامن وراء استمراره وتطوره، وعند غياب هذا المواطن وانعدام دوره تصاب الديمقراطية الناشئة بالانتكاس، فتتخبط بين خيارين: خيار التشرذم في ظل الاضطراب والفوضى مع وجود بعض الحقوق والحريات، وخيار الانتظام في ظل الاستبدادية والعبودية مع ضياع جميع الحقوق والحريات. وإذا أخذنا بالحسبان اعتياد هذه المجمعات على الخضوع وتحكم ثقافة الاستبداد فيها، فإنها وبعد تجربتها لحالة الاضطراب والفوضى غالبا ما ستختار في النهاية السقوط في فخ ما اعتادت عليه من أنظمة حكم مستبدة وغير إنسانية.
ما نريد قوله مما تقدم، وبقدر تعلق الموضوع بالديمقراطية الناشئة في العراق، هو: ان القلة القليلة من المواطنين فوق العادة الذين افرزتهم ديمقراطيتنا الهشة الناشئة بعد سنة 2003، من زعماء الكتل والأحزاب السياسية وغيرهم، ممن احتكروا القرار السياسي، وسيطروا على مراكز الثروة والنفوذ في بلدنا، وتلاعبوا بالقوانين والمؤسسات والقرارات لمصالحهم على حساب الأغلبية من المواطنين المثيرين للشفقة باتوا يشكلون الخطر الأكبر على هذه الديمقراطية، فهم لا يعرقلون مسارها الصحيح، ويمنعون تغلغل مؤسساتها وقيمها الأخلاقية في الثقافة السياسية العامة، بل انهم يزيدون كل يوم من تعاسة المجتمع، وتشرذمه وتشظيه تحت عناوين وانتماءات بدائية عديدة، وهذا الحال لن يدوم الى الابد على ما هو عليه، فمن طبيعة الانسان عدم صبره على التأرجح بين حرية منقوصة وعبودية منقوصة، لأنه سيختار في النهاية أحدهما بشكل ما، وقد اثبتت تجارب التاريخ البعيدة والقريبة ان أي ديمقراطية ناشئة تعجز عن التطور والاستقرار يكون سقوطها بيد اعدائها التقليديين من الفوضويين والطغاة مسألة وقت ليس الا.
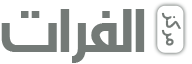










اضافةتعليق