في عام 1831 كتب جورج بوش (الجد الأكبر للرئيس الأمريكي السابق ) في كتابه (حياة محمد) يقول: "ما لم يتم تدمير إمبراطورية المسلمين فلن يتمجد الرب بعودة اليهود إلى وطن آبائهم وأجدادهم". وكان ذلك بعد أن خاض الأسطول الأمريكي في البحر الأبيض أول حروبه الخارجية ضد من وصفهم الساسة الأمريكيون آنذاك بـ (قوى التسلط والقرصنة الإسلامية) في إشارة إلى القراصنة الليبيين الذين كانوا يتعرضون للسفن التجارية الأمريكية في هذا البحر.
وتقودنا حلقات المسلسل التاريخي إلى نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشريين لتروي لنا قصة الحفيد الذي زعم مراراً: "إن الله قد دعاه ليرشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة في مهمة تدخل نطاق الخطة الإلهية لتصدير الموت إلى ربوع الأرض دفاعاً عن بلده العظيم وتخليصاً للعالم من رموز الشر" وذلك حينما قاد حرباً (صليبية) على حد وصفه أبلغه الرب بخوضها وقد فعل. وكان ذلك على خلفية الهجمات التي تعرض لها مركز التجارة والبنتاغون في عام 2001.
وعند إعادة تفحص وتركيب السلسلة التاريخية المحصورة بين المقالتين من منظور استراتيجي، تتوضح الرؤية أكثر، وتأخذ أبعاداً أكثر تعقيداً وشموليةً"
ويخطئ من يظن بأن الاستنزاف الأمريكي للإسلاميين قد بدأ بعد زوال الاتحاد السوفيتي عام 1991 أو بعد هجمات سبتمبر 2001 لأسباب بعضها تأريخي يتأتى من الضغوطات التي مارستها الولايات المتحدة ضد المسلمين في جنوب الفلبين بين عامي 1898 و 1945، والخسائر التي تكبدها الإسلاميون في خضم المواجهة التي خططت لها ودبرتها أجهزة المخابرات الأمريكية في سبيل احتواء الخطر الشيوعي بسلاح الإسلاميين تحت شعار: "إشهار سلاح الاعتقاد ضد تهديد الحاد" وذلك في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ايزنهاور.
وبعضها الآخر يتعشق في تراكيبية البناء الجيواستراتيجي للقوى المهيمنة وعلى رأسها الولايات المتحدة والمنطق الذي يحكمها، حيث إن التجربة التأريخية تفيد بأن كل قوة تحتل مركز الصدارة في الشؤون الدولية تواجهه تحديين أساسيين:
أحدهما: ينتمي إلى البعد الجيوبولتيكي للقوة والمتضمن تأمين القدرة في المجال العسكري على المحافظة على التوازن بين متطلبات الدفاع وبين الوسائل المتاحة لها لتلبية احتياجاتها في هذا المجال.
أما الآخر: فيتمثل في المحافظة على قاعدتها التكنولوجية الاقتصادية من التداعي النسبي في مواجهة الأنماط الجديدة منها.
ويترشح عن عملية الموازنة والتكييف بين المطلبين، ممارسة سياسة يناط بها تحقيق طيف واسع من الأهداف التي تجد جذورها في النسق العقيدي للقوة وركائز المعرفة؟
وما تقدم يثبت المضامين والتوجهات الأساسية في الإستراتيجية العظمى وأهدافها من ناحية، مثلما يرسخ القناعة بأن التغيير يطال فقط المدى الممكن تحقيقه منها وكيف يمكن تحقيق ذلك في إطار المرحلة التاريخية أو في مسميات ومداخل الحركة فيها من ناحية أخرى.
وهكذا يمكن إعادة رصد وتسمية الوثبة الإستراتيجية التي نفذتها الولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر 2001 ضد الإسلاميين، بوصفها نقطة شروع جديدة ومختارة في سياق استراتيجي أكثر شمولاً وتعقيداً (كما أسلفنا) وذلك بدلالة الأهداف والمصالح المرصودة ضمن حيزها، إذ وجدت الولايات المتحدة في تلك الهجمات فرصة للشروع بعصر البناء الامبريالي للنظام العالمي الجديد عبر التمدد والتواجد مكانياً في صور من الاختراق الجيويولتيكي لأعقد مناطق الصراع العالمي التي عرفها العالم منذ أيام الحرب الباردة، واختراق مماثل لمعاقل الثروة العالمية لتحقيق الحكم الأمريكي في السيادة العالمية، فكانت فكرة إعادة إحياء (المخافر الدولية) الوسيلة المثلى لتحقيق تلك الغاية مع السعي في الوقت ذاته من أجل إعادة المشروعية للنظام السياسي الأمريكي التي ثلمت بعد تلك الضربات. والأهم من ذلك إن هذه النقلة أو الوثبة الإستراتيجية كانت تتويجاً لمسعى الإدارة الأمريكية الذي يشغل الفراغ الذي خلفه الاتحاد السوفيتي وذلك سبيلاً لتأمين الحشد اللوجستي والمعنوي لرفد التوجهات الإستراتيجية للمرحلة الجديدة في مواجهة التهديد الإسلامي القادم من الشرق.
ومثلما كان ينظر للخطر الأحمر أبان الحرب الباردة، صار يروج للخطر الأخضر على إنه (سرطان دولي يفتك بالقيم الغريبة) أو على حد تعبير أحد الساسة الأمريكيين: "إن الإسلام مناسب لملئ دور (الشرير) بعد زوال الحرب الباردة، فهو ضخم ومخيف وضد الغرب، ويتغذي على الفقر والسخط كما إنه ينتشر في بقاع عدة من العالم". وكان في مقدمة من طرحوا أفكاراً عن ذلك العدو الإسلامي المحتمل، الباحث الأمريكي ذو التوجهات والخلفية الصهيونية (برناردولويس) في مقالة حملت عنوان (جذور السعار الإسلامي) ذكر فيها: "نحن نواجه عصراً تبدلت فيه أساليب المواجهة بحيث صعدت فوق مستوى القضايا، والمعضلات فوق مستوى الحكومات التي تطرحها وتجاوزتها، إننا إزاء ما يصل إلى مستوى الصدام بين الحضارات". ثم جاء صموئيل هنتنغوتون ليستكمل الحلقة الحضارية للصراع عبر التأكيد على: "إن الإسلام والحضارة الغربية على طرفي نقيض ولا يمكنهما التعايش، مما يجعل المصادمة بينهما محتومة" وفي خضم هذا الصراع المفتعل أعادت الإدارة الأمريكية إحياء إستراتيجية الاحتواء المخضرمة عبر مدخلين، توزعت على حلقات زمنية متداخلة:-
المدخل الأول: استنزاف القوى الإسلامية (المتشددة والمعتدلة) واستبعادها بعد فرض الحجر عليها ومكافحتها باستخدام أسلحة النظم السياسية الاستبدادية وإعلامها أي باستخدام وسيلة المجابهة والإعياء غير المباشرة. وقد عبرت الكاتبة الأمريكية (جوديت ميلر) عن هذا التوجه بالدعوة إلى توظيف توجه غير ديمقراطي واستبعادي تجاه العالم الإسلامي، وهذا يتطلب من صانعي القرار في الغرب (أن لا يؤيدوا الانتخابات الديمقراطية في العالم الإسلامي لأنها ستوصل أصوليين متشددين إلى السلطة) وهذا التوجه الذي نراه شاخصاً فيما كتبه (مارتن انديك) –المسؤول عن الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مجلس الأمن القوى الأمريكي- في التقرير الختامي لندوة (الإسلام والولايات المتحدة) التي نظمها معهد واشنطن –المعروف بانحيازه الشديد لإسرائيل وتأثيره الكبير في ترسيم السياسة الأمريكية بحيث نصح الساسة الأمريكان بأن: تكون الساحة السياسية في الشرق الأوسط مقصورة على الأحزاب العلمانية كلما كان ذلك ممكناً، وحصر نشاط الحركات الإسلامية المعتدلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية معارضاً دمج حركات الإسلام السياسي المعتدلة في الساحة السياسية وإعطاءها المشروعية".
وقد انعكست الترجمة العملية لهذه الأفكار والدعوات على السياسة الأمريكية لما غضت الطرف وأعطت الضوء الأخضر للممارسات القمعية وحملات التشويه المنظمة التي اتبعتها النظم الاستبدادية في الشرق الأوسط ضد الإسلاميين، مع فرض الحجر السياسي عليها وإقصاءها عن المشاركة السياسية كما حصل في الجزائر وتونس، وإحاطتهم بسياج شائك من القوانين الاستثنائية مثل قانون الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب ومحكمة القيم، وهذا ما حصل في معظم الدول الإسلامية وفي مقدمتها مصر.
المدخل الثاني: استنزاف القوى الإسلامية (المتشددة حصراً) عبر المواجهة العسكرية المباشرة وهذا ما حصل مع إدارة بوش الابن بعد عام 2001، إذ توجه هذا الأخير في خطاب وجهه للكونغرس بتاريخ 20 أيلول حدد فيه أبرز ملامح الإستراتيجية الأمريكية في مواجهة الإرهاب الإسلامي وغيره مبيناً فيه: "إن حربنا ضد الإرهاب تبدأ بتنظيم القاعدة في أفغانستان لكنها لا تنتهي هناك، إنها لن تنتهي حتى يتم العثور على كل مجموعة إرهابية في العالم وحصارها وهزيمتها. وعلى كل امة وكل منطقة أن تتخذ قرارها الآن: أما إنكم معنا أو مع الإرهابيين وكل امة تواصل إيواء الإرهاب ستعتبر نظاماً معادياً للولايات المتحدة".
لهذا كان يجب تحضير الشعب الأمريكي لصراع ضد الإسلام لا هوادة فيه، ولتطوير سياسة احتواء والتفاف تكتيكي ومبادئ عملية جديدة مع إيجاد نخبة جديدة في السياسة الخارجية مختصة في الإسلام وشؤونه.
وقد جاءت هذه الخطى مع قدوم إدارة (اوباما) الذي أظهر للمسلمين وجهاً جديداً أكثر إشراقاً مع إخفاء سلاح أكثر اختراقاً ودهاءً من سلاح الإدارة السابقة عبر الالتفاف التكتيكي على محاور القدرة الإسلامية سبيلاً لخنقها وعزلها عن العمق الاستراتيجي الإسلامي كما حصل في فلسطين ولبنان.
إن استجماع ما تقدم لن يبشر بقرب انفراج العلاقة بين الولايات المتحدة والقوى الإسلامية –المتشددة خاصة- وإنما تبدل تكتيكي في أنماط الحراك الاستراتيجي الأمريكي حيال كل القوى الإسلامية، ولن تكون الديمقراطية وفق هذا المنظور إلا خاصرة رخوة لتمرير التطلعات وتوسيع مساحة النفوذ الأمريكية على حساب التراجعات التي تلحق بالإسلاميين في هذا المضمار.
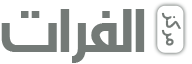
اضافةتعليق